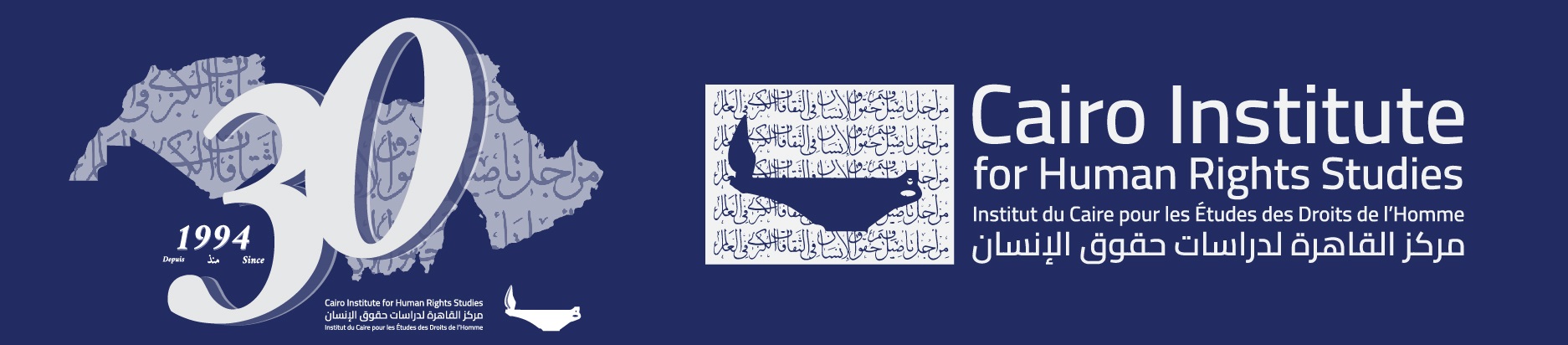محمد سيد سعيد
جريدة الأهرام، 5 مارس 2007
كنت قد اقترحت أن تعاد صياغة المادة الثانية من الدستور لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية والمسيحية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادر الرئيسية للتشريع، وتلقيت ردودًا كثيرة بعضها وُجه لي بالاسم، وبعضها اكتفي بمناقشة ونقد أو نقض الاقتراح أو ما تضمنه من حجج وآراء.
لعلي أعترف بأن شيئًا من الذهول أصابني عند قراءة أكثر الردود التي نشرت أو وصلتني بطريق مباشر.
ومشكلتي الأولي مع غالبية هذه الردود هي أنها لا تكاد تلامس القضايا والمشكلات التي تثيرها المادة الثانية من الدستور، ولا قيمة ودلالة الاقتراح بالتعديل الذي طرحته مع قليلين غيري. أما المشكلة الثانية والأكثر خطورة فهي أن غالبية الردود حاولت أن تفرض فرزًا مصطنعًا كليةً، فالقصد منها هو تصوير أنصار الصياغة الحالية لهذه المادة وكأنهم المتدينون الحقيقيون أو أنصار الإسلام، وأن من يقترحون التعديل أقل تدينا أو حماسا للإسلام، وبرأيي أن هذه الحيلة المبتذلة هي امتداد للتوظيف السياسي للشريعة الإسلامية نفسه زوال تاريخه المديد، مما أضر ضررًا شديدًا بالمجتمعات الإسلامية، وشوه صورة الإسلام في عيون العالم.
لاحظوا أن الحماس الصاخب للشريعة لا يحمل أي دلالة في واقع الأمر على فهم قيم الإسلام، أو تبني رسالته العدالية، ولا حتى رسالته الإلهية الحقة، أي رسالة التوحيد.
وليس همي هنا أن أشرح فلسفة التوحيد في الإسلام، وما تنفرد به من دلالات عظيمة، فيكفينا أن نشير لأعمال فلاسفة المعتزلة، ما أركز عليه بشكل خاص هو إحدى أعظم دلالات التوحيد في المجال السياسي: أي مناهضة ثقافة الخوف من الحكام ومقاومة انفرادهم بالسياسة وبالقرارات التي تسير شئون الناس والمجتمعات بمن فيها من مسلمين وغير مسلمين. فثقافة خوف الحكام ومداهنتهم تشتبه مع الشرك بالله الذي يجب على البشر ألا يخشوا سواه.
لهذه المقدمة هدف واضح لا لبس فيه، وهو كشف الحيلة التي أشرنا إليها: أي التلاعب بالمشاعر الدينية للناس من أجل تحقيق أهداف سياسية تنتهك بصورة بالغة الفظاظة والعنف جوهر الإسلام التوحيدي ومجمل مبادئه العدالية والأخلاقية، وطوال قرون أمكن لكثير من المستبدين وأعوانهم قلب الأمور وتوظيف الشريعة لتبرير الاستبداد وعنف السلطات السياسية. ولو تركنا التاريخ وصرفنا أنظارنا للحاضر وحده لما وجدنا الأمر مختلفا بالمرة، بل ذهب النظام السياسي في بلد عربي بعينه إلى أقصي مدي ممكن في التوظيف السياسي للشريعة لتبرير الاستغناء التام عن الدستور بالقول بأن: القرآن هو الدستور.
ولماذا نعطي أمثلة بعيدة؟ لقد تحسن الوضع كثيرًا ولكن لا يزال أعضاء وأنصار حركات الإسلام السياسي يهتفون في التجمعات بأن القرآن هو دستورنا، وهو ما يذكرنا بالوضع القانوني في البلد العربي الشقيق نفسه: أي غياب الدستور والقانون تمامًا تقريبًا.
لقد تطورت بعض الحركات الإسلامية فكريا بصورة ملحوظة بعد أن أدركت ما فهمته البشرية كلها منذ قرون. فالمجتمعات تحتاج حاجة ماسة لدستور ينظم علاقة الدولة بالمجتمع، ويحميه من عسفها، ويعين كيفية تولي وظائف السلطة بالانتخاب الشعبي والعلاقة بين هذه السلطات بما يحول دون الاستبداد ويضمن الحماية الدستورية والقانونية للحريات العامة وحقوق المواطنين والبشر عمومًا، غير أن هذا التطور لا يزال محجوزًا ومعاقًا في بلادنا بعوامل كثيرة منها استمرار الهتاف نفسه بين الحركات الإسلامية.
هل نحتاج لمزيد من الإيضاح. القول بأن القرآن هو الدستور ـ سواء بالصياغة التي تأخذ بها بالفعل دولة عربية كبيرة، أو بالصيغة التي مازالت حية في التقاليد الهتافية لحركة الإخوان المسلمين وأنصار الإسلام السياسي بصورة عامة ـ يعني إلا تلتزم الدولة بأي شيء في المجال السياسي مقابل التزام المجتمع بالطاعة الكاملة للدولة حتى لو كانت فاسدة وظالمة. فالقرآن الكريم لم يتحدث عن الدولة بالمعني المؤسسي على الإطلاق، ولم ينشئ سوي بعض المعاني العامة فيما يتعلق بكيفية تولي سلطات الدولة ولا فيما يتعلق بحدود هذه السلطات ولا طبيعة علاقاتها المتبادلة، ولا طريقة مباشرتها لوظائفها ومحاسبة المسئولين عن ممارساتها.
ترك القرآن الكريم قضية التنظيم السياسي للمسلمين وغيرهم من الناس ليقرروه بأنفسهم، وبذلك فإن القول بأن القرآن هو دستورنا يعني في الجوهر أن يترك المجتمع للسلطة أن تقرر ما تشاء بجميع الشئون تقريبًا، غير ملتزمة سوي بعدد محدود للغاية من النصوص الشرعية المتعلقة بالمعاملات المدنية: أي علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض وخارج النسق السياسي، هل يحتاج أحد لأدلة إضافية حول أن هذا القول هو المدخل أو الحيلة السهلة لتبرير وتشريع الاستبداد الكامل وللحكم المطلق بكل شروره ونتائجه المدمرة؟
وجه الخطورة
هنا هو ما فعله أيضًا الرئيس السادات عندما أراد أن يفتح الباب المغلق بقيد الولايتين في دستور 1971 لتجديد رئاسته لمدد أخري لا قيود عليها، ولكن الأمر الأكثر خطورة بكثير هو أن الرئيس الراحل لم يكن يكتفي بهذا الهدف الذي حصل عليه بالاستفتاء الشعبي، ذلك أنه كان يرغب في الواقع في توظيف النص المعدل للمادة الثانية في التنكيل بخصومه السياسيين، وكان قد بدأ فعلًا في ترجمة هذا النص المعدل لهذا الغرض، فوضع صياغة لتشريع باسم قانون الردة ومسودة لتشريع آخر باسم قانون الحرابة، وكان من المقرر اتخاذ التدابير لإقرار هذه التشريعات لولا أن حفظها الرئيس مبارك في أدراجها.
هذا يكمن الخوف المشروع تمامًا من النص بصيغته الحالية: أي أنه يفتح الباب لوضع تشريعات استبدادية تعصف بالحريات العامة وتنسف نسفًا بعض الحقوق الجوهرية للإنسان والمواطن، فكان من السهل على الرئيس السادات وسيكون من السهل لأي رئيس آخر أن يستعمل هذا النص فيصدر تشريعًا باسم قانون الحرابة مثلًا ويستخدمه ضد أنصار التيار الإسلامي، وأن يصدر تشريعات مماثلة لما تباشره السلطات الإيرانية من عسف بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية، بل للأخطر بكثير: أي تلك التي صدرت عن الحكم الإسلامي في السودان منذ انقلاب عام 1989, وكفلت للسلطات الانقلابية تصفية تقاليد التسامح التاريخية في السودان، والعصف بمكتسبات ثورة 1985.
ويهمني أن أشير إلى الندم الشديد الذي أعلنه السيد حسن الترابي مهندس الانقلاب الإسلامي في هذا البلد العربي العزيز، ولو كان بعض أنصار الإسلام السياسي يتصورون إصدار تشريع مثلًا باسم قانون الردة لتصفية المثقفين بدنيًا مثلًا فعليهم تدارس السهولة التي يمكن بها استخدام هذا التشريع ضدهم هم ذاتهم، كما حدث في السودان وفي إيران وغيرهما من التجارب التاريخية والحاضرة.
قد يقول البعض إن ما يصنعه المستبدون بالشرع الإسلامي قد يصنعونه بأي تشريعات أخري، وهذا قول صحيح، لكن في الحالة الأولي يوظف الدين في إضفاء الشرعية بل والقدسية على هذه التشريعات والممارسات، وسوف يتحمل أنصار هذا التوظيف المسئولية الأخلاقية أمام الناس والمسئولية الدينية أمام الله لما يمثله هذا الموقف من مخادعة، ولما يفرزه من نتائج.
يقول أنصار هذا النص أيضًا: إن هناك حركة قوية للاجتهاد وإبراز الوجه الصحيح للدين الإسلامي وقيمه السامية، وبذلك نكون قد حققنا أفضل تفسير للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأمور مثل المساواة أمام القانون، ونوافق من حيث المبدأ على أن ثمة اجتهادات هائلة ومقدرة مثل اجتهاد الدكتور محمد سليم العوا الذي أكد أن الديمقراطية هي النظام الذي يتفق مع الإسلام وشريعته، ولكن سؤالنا لأنصار هذا الاتجاه أو هذه الحجة هو: من يضمن لنا أن ينتصر الاجتهاد العقلي والإنساني للشريعة والذي يعزز الحرية وحقوق الشعب والمواطن، خاصة في وقت تتسم فيه الحركات الإسلامية الراهنة بقدر ملحوظ من الرجعية والجمود، بل والعنف؟ فإن لم تنتصر تلك الاجتهادات، من يضمن لكم حياتكم نفسها وحقوقكم الإنسانية حتى كمفكرين كبار في شئون الدين؟
حلًا لهذه المعضلة اقترحت أن نحافظ على النص بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن نضيف مصدرًا آخر مكملًا ومفسرًا وهو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فنضمن بذلك أن ننتصر ابتداءً لهذه الاجتهادات التي تفسر الشريعة تفسيرًا يتفق مع أرقي ما أنتجه العصر من معايير في المجالين السياسي والمدني.
Share this Post