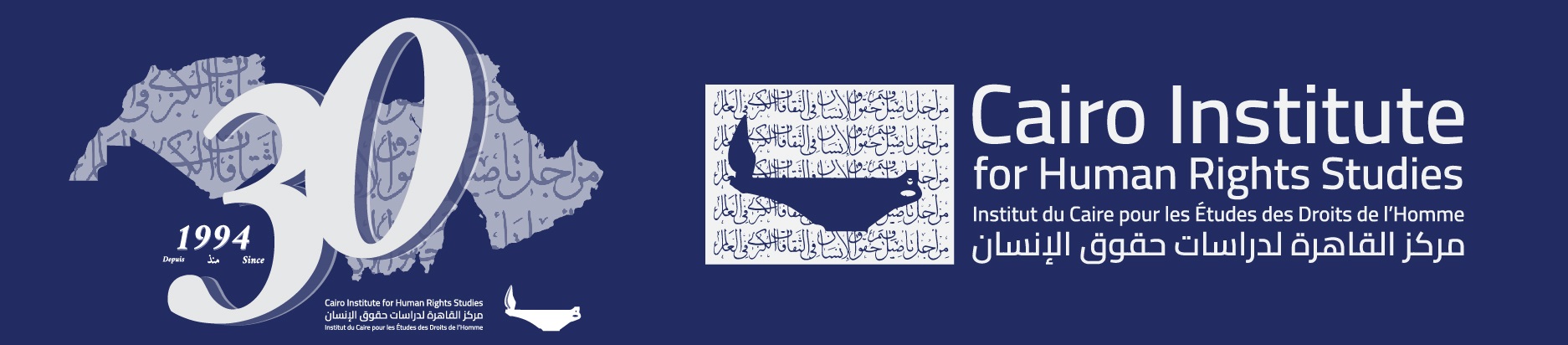كمال جندوبي
ناشط حقوقي في تونس ورئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. شغل منصب وزير مكلّف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية من فبراير 2015 إلى أغسطس 2016.
منذ عام 2011 أصبح مسجد الزيتونة، وهو مركز التعليم الإسلامي في تونس، محلّ صراعات مريرة بين مناصري إسلامٍ مستنير وأنصار إسلامٍ أكثر تشددًا.
منبر
هل سنبقى مكتوفي الأيدي نشاهد الجرائم الإرهابية المرتكبة على أيدي تونسيين، مثل جريمة القتل الوحشية للموظفة بمركز شرطة رامبوييه، بإقليم إيفلين «ستيفاني مونفيرمي» على يد التونسي جمال ڤرشان في 23 أبريل؟ وقبلها مقتل ثلاثة من المصلين في كنيسة نوتردام في نيس عام 2020؟ وقبلهما الجريمة التي ارتكبها إرهابي تونسي (من قرية جمال ڤرشان) عام 2016، في مدينة نيس أيضًا؟ هل سنستمر في المعاناة من تحرّج سلطاتنا وأوساط الصوابية السياسية من اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروّجي الكراهية والعنف، حتّى داخل مجلس نواب الشعب في تونس؟ ألم يبرّر النائب «راشد الخياري»، اغتيال أستاذ التاريخ صامويل باتي في كونفلان سان أونورين في 16 أكتوبر 2020 دون أن يتعرض لأي مضايقة؟ ولم يلق تصريحه تفاعلًا أو ردًا حازمًا سوى من نشطاء المجتمع المدني، سواء في تونس أو في فرنسا؟ هل سنستمر في استبطان الذنب «الجماعي»؛ عن هذه الجرائم التي تستهدفنا وتحتجزنا كرهائن، بما أنّها تُرتكب باسمنا وباسم الدين الذي ننتمي إليه، الإسلام؟ وهذا يجعلها مهمة مزدوجة.
التطرّف على الطريقة التونسية
يصطف معظم التونسيين مع المجموعة التي تبرّئ الإسلام من هذه الجرائم من خلال تصنيف مرتكبيها باعتبارهم قلّة قليلة للغاية! وفي الوقت ذاته، تنتشر الدعوات العاجلة للاختيار بين «معسكر الأسوأ»: أي مصنع العنف والكراهية والإرهاب، أو «المعسكر الأقل سوءً»: وهو القبول بالسياسات الأمنية والقمعية، وانتهاكاتها لحقوق الأفراد وكرامتهم، والتي تؤدي غالبًا إلى ما يسمى بالعنف المشروع، والذي يغذّي بدوره العنف الإرهابي المضاد.
لا يمكننا الاكتفاء بتحليل خصائص الشخصية والأسباب والظروف، بل يجب أن نفهم أن الشر فينا وبيننا قبل كل شيء. فمنذ بداية «الربيع العربي» في 2011، نشهد نوعًا من التطرف التونسي. ولا يعني هذا أنّ هذه الظاهرة لم تكن موجودة قبل 2011، بل على العكس تمامًا؛ لقد نبتت هذه الظاهرة تحت تأثير التفكّك المزدوج: تفكّك الرابط الاجتماعي وتفكّك الرابط الوطني. فأصبح الجهاد، نوعًا ما، هوية بديلة لأولئك الذين يفتقدون الإحساس بالهوية، من الشباب الذين هم «خارج المنظومة»، المستبعدين من نظام مدرسي يعاني من أزمة بمعدل 100.000 شاب سنويًا، والعاطلين عن العمل مجهولي مستقبل. أما حضانات هذه الهوية الجهادية فمعروفة جيدًا، هي القنوات التلفزيونية الفضائية التي تمولها ممالك النفط وتنقلها مختلف المنظمات وخطباء المساجد، وتتنامى في السجون التي تحوّلت إلى أماكن للاستقطاب والتجنيد.
ترعرع السلفية
لا تقتصر ظاهرة الجهاد والتعصب على تونس فقط، إلّا أنّ ازدهارها هنا منذ 2011 هو أيضًا نتيجة لتعاقب الأحداث والقرارات. إذ أدى سياق ما بعد الثورة إلى فتح نوافذ حرية التعبير بشكل جامح، ولأنه لا مجال لتعايش الحرية والتعصّب جنبًا إلى جنب، برزت السلفية بشكل عام، والجهادية تحديدًا. وتفاقمت هذه الظاهرة بسبب العفو عن القادة الجهاديين –المسجونين منذ التسعينيات، وتراخي بعض الحكام –بسبب السذاجة أو لحسابات أخرى– وحرب المساجد وخيام الوعظ، وحفلات التكفير التي ينادي السلفيون فيها بعزل الكفار.
أتاح غياب سلطة الدولة وتخليها عن البعد الاجتماعي إلى جانب نوع من العمى السياسي كافة المعززات لتطور هذه الآفة، من جبال الشعانبي على الحدود الجزائرية التونسية، إلى الشرق الأوسط مرورًا بأوروبا.
ولكن ماذا عن السياسة الدينية؟ فرّغم الإقرار بعدم تدخل الدولة في الدين، إلّا أنها ملزمة بالاهتمام بالبعد الجماعي والاجتماعي للدين وحماية دور العبادة. فثمة سياسة دينية (في هذه الحالة، سياسة للإسلام) مثلما توجد سياسة ثقافية وتعليمية. تتمثّل هذه السياسة في تنظيم ممارسة العبادة في الفضاء العام –إدارة المساجد، والأعياد الدينية، والحج– وتعليم الدين، والأحوال الشخصية، والمسائل المتعلقة بالزواج: وغيرها من الأمور العديدة التي ينبغي أن تكون خاضعة للدولة، لا للتدخل المتنافر لسديم من الجمعيات الخارجة عن الرّقابة.
التراخي والهوس بالهوية
لقد أدّى انهيار الدولة في أعقاب الثورة إلى تهيئة وضع ملائم لارتكاب انتهاكات جسيمة؛ كضم جزء من المساجد من قبل التكفيريين؛ والخلط بين الوعظ والمعرفة الدينية ممّا سمح بصعود أئمة متشددين على رأس المؤسّسات الدينية، بما في ذلك مسجد الزيتونة في تونس، وأيضًا في وسائل الإعلام. بالإضافة إلى انتشار الجمعيات «الدينية» الخارجة عن السيطرة، ورياض الأطفال «القرآنية» التي تعمل خارج نطاق التربية الوطنية وقواعدها، والهجمات على المفكرين والفنانين الأحرار.
لقد استفاد كل ما سبق من التراخي والهوس بالهوية وأصبح للمتطرفين أجنحة. ومن ثم، فإصلاح السياسة الدينية كما لخصه المرحوم الباجي قايد السبسي –رئيس الدولة بين ديسمبر 2014 ويوليو 2019 – يتلخص في جملة واحدة هي: «بلد مسلم ودولة مدنية» وهي مهمة عاجلة وطويلة الأجل ويجب أن تشمل جميع أصحاب المصلحة.
إذا لم نتمكّن من ذلك سنستمر المعاناة من شرور الدعاة الذين يظهرون تقواهم الاستعراضية كنوع من الكفاءة في ظل تهاون بعض الأحزاب ووسائل الإعلام. وستتحول المساجد، والتي تقارب 6000 مسجدًا، إلى منتديات سياسية وأماكن للتعبئة الانتخابية للإسلاميين والسلفيين، وتتواصل حالة الخروج على القانون التي تسود اليوم الجمعيات الدينية التي تشهد العديد من التجاوزات.
يجب علينا كتونسيين التحلي بالشجاعة والتصميم لفهم ما يحدث لنا، من خلال تنظيم حوار وطني حول هذه المسألة، ليس كما أٌعلن عن حوار وطني ثم سرعان ما تمّ التخلي عن الفكرة. نحن لا نفتقر للنداءات ولكنها لم تُسمع قط.
كأننا أردنا النجاة، ولكن رفضنا النظر إلى ما يقوّضنا.
التعهدات لحركة النهضة
عندما كلّفني رئيس الحكومة الحبيب الصيد في 26 يونيو 2015، غداة هجوم سوسة، الذي خلّف 39 قتيلًا، بالتحضير لمؤتمر وطني حول الإرهاب، لمست حجم المقاومة والجبن. أكثر من شهرين من الاستعدادات والمماطلات باءت بالفشل.
لقد كان واقعًا… والرسالة واضحة ألاّ نفعل شيئًا وننتظر! ومن الواضح أن الأوساط العليا في الدولة والأحزاب السياسية الرئيسية فضلت التريّث استنادًا إلى تعهدات حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي –الشريكة في الحكومة– والتي كانت تخشى –ولها أسبابها– من تحول المؤتمر لمحاكمة ضدّها. واتضح لي آنذاك إلى أي مدى قادتنا عاجزين مفتقري الإرادة.
ومنذ ذلك الحين، وتحت ضغط دولي، تم وضع استراتيجية واتخاذ عدة إجراءات، كان لها أحيانًا نتائج مهمة في المجال الأمني، ولكن دون معالجة لنقاط الضعف الهيكلية التي تتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا لمقاربتنا.
وهذا هو معنى النداء الذي أطلقه التونسيون بالخارج لوضع حد لهذه الخسارة.
المصدر: تم نشر المقال لأول مرة باللغة الفرنسية على le monde
Share this Post