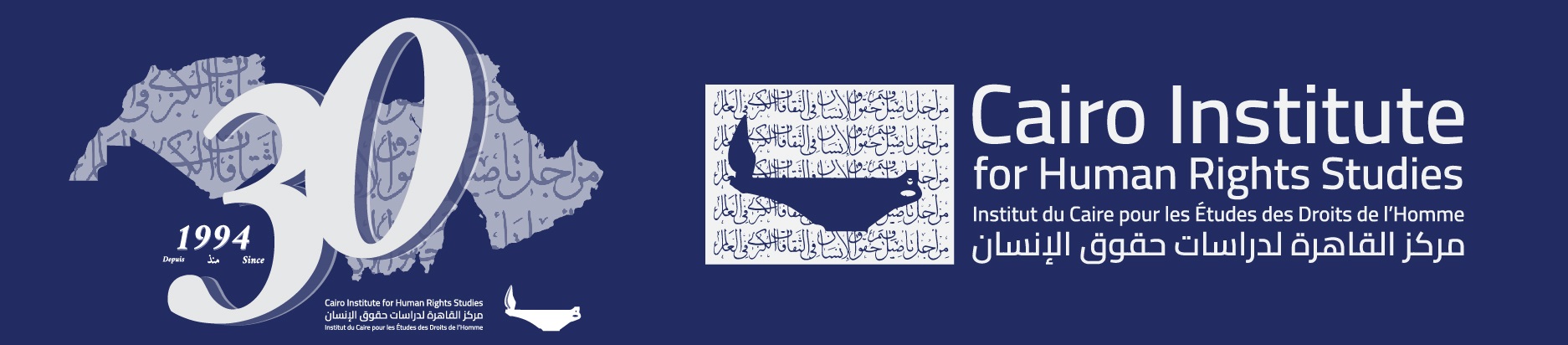بهي الدين حسن
يعيش العالم العربي على فوهة بركان، نتيجة للتفاعل الملتهب الجاري بين عدة عوامل: جماعات الإرهاب التي ازداد نفوذها وانتشارها، والعنف المتصاعد الطائفي السني/ الشيعي، وظاهرة الميلشيات الخاصة غير السياسية، والتطرف الديني المتزايد التأثير سياسيا ومجتمعيا، والاستبداد السياسي المتعاظم وصولا لتعميق ركائز الدولة البوليسية في بعض الدول، والاستهداف المتزايد لدعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان، في سياق تدهور نوعي أكبر في وضعية حقوق الإنسان ككل، وأخيرا المؤشرات المتوالية لاحتمال اندلاع حروب أهلية في عدة دول و/أو حروب إقليمية.
إن «قوارب الموت» العابرة للبحر المتوسط أملا بالانتقال لنعيم الحياة في «الجنة» الأوروبية، وموجات الانتحاريين المتوالية الآملة بالانتقال الى «الجنة الأبدية»، وملايين اللاجئين العراقيين والسودانيين العابرين لخطوط التماس داخل العراق والسودان، أو للبحار وللحدود –حتى مع إسرائيل!- هي الحمم الإنذارية الأولى للبركان، الذي ما زال في بداية غليانه، وعندما يصل إلى ذروته، فإن حممه ستعبر كل الحدود والتوقعات، بحيث أن «الحادي عشر من سبتمبر» الجديد ربما يفوق خيال أكثر المتشائمين تشاؤما.
لم يكن الوصول إلى هذه المحطة حتميا، إلا بفضل عدة عوامل، على رأسها انكسار الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي في العالم العربي.
بعد فشل ثلاث موجات عالمية للتحول الديمقراطي في اجتياز السواحل المنيعة للعالم العربي، خارت قوى الموجة الرابعة واستسلمت أمام القلاع العربية الحصينة، مكتفية بنجاحها في اقتحام قلاع صربيا وجورجيا وأوكرانيا، رغم أن الموجة الرابعة عند توجهها صوب سواحل العالم العربي، حازت على قوة اندفاع هائلة صوب هذه المنطقة بالذات، وذلك بسبب هجمات 11 سبتمبر – ثم تفجيرات مدريد ولندن- وما ترتب عليها من وضع خطط أوروبية خاصة «سياسة الجوار»، وأميركية (مبادرة الشراكة)، ودولية (منتدى دول الثمانية للمستقبل)، وتخصيص وضخ أموال لهذا الغرض بملايين الدولارات.
من المفارقات التي لا تخلو من مغزى أن القلاع العربية الحصينة في مواجهة الديمقراطية، تهاوت في مواجهة أعمال الغزو والاحتلال الأجنبي، حيث جرت خلال نفس الفترة 2001- 2005، إعادة احتلال الضفة الغربية وأجزاء من غزة وجنوب لبنان، فضلا عن كل العراق -بمساعدة أحيانا من دول عربية قاومت بصلابة موجات الديمقراطية- بينما لم تتحول دولة عربية واحدة نحو الديمقراطية خلال نفس الفترة، بل إن الأمر يشير إلى حدوث انتكاسة كبرى، ليس بالمقارنة فحسب بهدف تحقيق الديمقراطية، بل ربما حتى بالأوضاع التي كانت سائدة في العالم العربي قبل 11 سبتمبر 2001.
أما ملامح انحسار الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي، فهي:
– تراجع الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بسياسة الجوار في العالم العربي، الأمر الذي انعكس في وضع خطط عمل ثنائية هي أقرب للوثائق الأدبية، التي لا يترتب عليها التزامات عملية ملموسة، ويصعب على الأطراف الشريكة، أو أي طرف ثالث (كالمجتمع المدني) أن يضع مؤشرات ملموسة لتقييمها أو دفعها للأمام.
– تخلي منتدى الدول الثماني من أجل المستقبل عن هدفه الرئيسي، في أن يكون منتدى للحوار المتكافئ بين الحكومات العربية والمجتمع المدني، للتأثير الملموس على عملية الإصلاح، ليصبح منتدى للخطابات الإنشائية، عاجزا حتى عن إصدار أي بيان سياسي ذي مغزى. ولم يكتف المنتدى بتهميش دور منظمات المجتمع المدني، بل سمح للحكومات بالمشاركة في تمثيلها أو في اختيار من يمثلها!
– تحول مبادرة الشراكة الأميركية إلى مجرد ذراع مالي ضخم لضخ الأموال، تحت عناوين مقطوعة الصلة في بعض الأحيان بأهداف المبادرة -خاصة في ظل عزوف أغلبية المنظمات ذات المصداقية عن التعامل المالي مع المبادرة أو مع وكالة التنمية الدولية الأميركية- أو بإهدارها في برامج عديمة المغزى، بسبب التشخيص السياسي الخاطئ لطبيعة النظم العربية السائدة، باعتبار عدد منها يرغب في التحول للديمقراطية، أو بسبب خشية إثارة غضب أنظمة حليفة تقدم خدمات أمنية وسياسية حيوية.
– تراجع كبير –أقرب للانهيار- في أداء القوى الداعية للإصلاح من داخل المجتمعات العربية، بينما لم يفلح الحراك السياسي خلال العامين الماضيين في خلق وقائع جديدة مؤثرة على علاقات القوى المختلة بشكل هائل لصالح النظم الاستبدادية في العالم العربي، والتي بدأت في شن هجوما مضادا لتقطع الطريق على احتمالات أي حراك سياسي جديد.
– دخول أطراف دولية جديدة (روسيا والصين وإيران) لا تحمل أجندة ديمقراطية بل هي معادية لها، إلى ميدان الفعل السياسي والاقتصادي المؤثر في المنطقة، في نفس الفترة التي تشهد –وستشهد المزيد- من تراجع النفوذ الأميركي بعد انهيار مشروع العراق.
المؤشرات الثلاثة الأولى تبلورت بوضوح قبل فوز جماعة الإخوان المسلمين بـ 20% من مقاعد البرلمان المصري في كانون الأول (ديسمبر) 2005، وفوز حركة حماس بالأغلبية في الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) 2006. وهو التطور الذي يعزو إليه بعض المراقبين التراجع في الموقف الأميركي والأوروبي –والدولي بالتالي- من قضية الإصلاح الديمقراطي للعالم العربي.
غير أن الأمر لم يكن تراجعا –بل وفقا لمثل عربي معروف «القشة التي قصمت ظهر البعير» أو «القطرة التي جعلت الإناء يفيض بالماء خارجه». فلم تتوافر منذ اللحظة الأولى للإعلان عن المبادرات الدولية المتوالية لإصلاح العالم العربي، الإرادة السياسية الكافية للدفع بهذه المبادرات بعزم لتحقيق أهدافها. لقد كانت أقرب لنمط إعلان النوايا السياسية، ولكنها افتقرت للإرادة والتشخيص الدقيق والخطط العملية. ويرجع ذلك للأسباب التالية:
– عدم حسم الصراع بين أولوية المصالح الأمنية لأوروبا وأميركا في العالم العربي –التي تتطلب الحفاظ على استقرار النظم الحالية في أغلب البلدان العربية- وبين الأولوية الجديدة المعلنة بعد 11 سبتمبر للتحول نحو الديمقراطية على حساب استقرار هذه النظم، وبالتالي المصالح الأمنية التي تحميها.
– حدة الانقسام بين أوروبا والولايات المتحدة، ليس فقط حول مشروعية وصواب مشروع غزو العراق، ولكن أيضا حول الفكرة المركزية لمشروع الإصلاح الديمقراطي للعالم العربي، أي الربط الوثيق بين تعاظم مخاطر الإرهاب والافتقار للديمقراطية، وأيضا حول خريطة الطريق نحو الإصلاح (المعدلات والوسائل والضغوط اللازمة). وهى خلافات لم تحصر نفسها داخل الغرف المغلقة، بل جرى التعبير عنها علنا، وبأساليب خشنة في كثير من الأحيان، مثلما حدث في اجتماعات قمة الثماني (أتلانتا 2004) وقمة أوروبا/ الولايات المتحدة (دبلن 2004) وفي المداولات العلنية وكواليس اجتماعات المنتدى من أجل المستقبل.
– رغم أن الولايات المتحدة الأميركية كانت الأكثر اندفاعًا وضجيجًا في تبني شعار الإصلاح الديمقراطي، حتى أنها وقفت مباشرة خلف مبادرتين من ثلاث، إلا أنها كانت أكثر انقساما من أوروبا حول صواب وأولوية الهدف، ليس فقط بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل داخل الإدارة نفسها، التي عانت فصامًا مستحكمًا. فهي تدعو لاحترام حقوق الإنسان في العالم العربي من ناحية، وترتكب بالتوازي عدد من أكثر جرائم حقوق الإنسان فظاظة في جوانتانامو وأبو غريب وغيرهما! تستخدم السجون السرية في الدول التي تدعو لدمقرطتها بالنهار، في تعذيب في الليل المحمولين بطائرات CIA إليها لانتزاع الاعترافات منهم! فضلا عن الدفاع علنا عن عدم الالتزام بمعايير حقوق الإنسان (خاصة فيما يتعلق بالتعذيب) وبالقانون الدولي الإنساني (فيما يتعلق بأسرى جوانتانامو)! هذا لا يعني أن أوروبا لم تعان من الانقسام، ولكنه الانقسام التقليدي الموجود قبل 11 سبتمبر بين دول الشمال -الأكثر اهتماما بحقوق الإنسان في العالم العربي- ودول جنوب أوروبا الأكثر تفهما وتفاهما مع الحكومات المستبدة في المنطقة.
– لعب التقييم الخاطئ لطبيعة أغلبية النظم العربية الحاكمة، واعتبارها تملك إرادة للإصلاح، وليست مناوئة له، دورا هاما في إهدار تحقيق المستهدف بالدعم المادي لقوى الإصلاح ومنظمات المجتمع المدني. فقد ذهب قدر كبير منه إلى حكومات ومؤسسات ومنظمات حكومية، بوهم أنها تنفق في أنشطة تدفع بعجلة الإصلاح، أو ذهبت في برامج مستوردة من تجارب دول على طريق التحول الديمقراطي (كوسط وشرق أوروبا) ولا تصلح في دول استبدادية معادية للديمقراطية. مثال ذلك برامج تنشيط المشاركة السياسية والانتخابية ومراقبة الانتخابات وتطوير النظم الانتخابية وغيرها من البرامج التي تركز على الجوانب التقنية للعملية الديمقراطية، والتي أنفق فيها قسم كبير من الدعم الأميركي، ولم تترك أثرا، لأن الشعوب لا تعتبر نفسها طرفا، فهي لا تثق بالنظم الراهنة، ولا بالانتخابات التي تديرها هذه النظم، وربما لا تؤمن بأن التغيير سيحدث بطريق الانتخابات، مهما تحسنت تقنياتها ظاهريا.
وباستثناء التصريحات الصحافية والتحويلات المالية الموجهة للمنطقة ككل، فإن سنوات صخب الحديث الدولي عن الإصلاح الديموقراطي للعالم العربي (2004- 2005) لم تستهدف فعليا سوى عدد أقل من أصابع اليد الواحدة من الدول العربية، ولم تعرف المنطقة أي خطة عمل ملموسة مترجمة على الأرض، أو ضغطا سياسيا دوليا جماعيا متواصلا من أجل الإصلاح.
حقيقة الأمر إذن، أن موجات الديمقراطية كانت خائرة القوى حتى قبل أن تصل إلى السواحل العربية، لذلك فإنه مع عودة أوروبا والولايات المتحدة إلى مواقع ما قبل 11 سبتمبر، فإن الموجة الرابعة لم تخلف وراءها أي تغير مادي ذي مغزى على الأرض، أو حقيقة إصلاحية دستورية أو تشريعية أو مؤسساتية، أو تغيرا في علاقات القوى، برغم أن ملفات ونصوص اتفاقيات خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية، والخطب النارية حول مبادرة الشراكة الأميركية، ومحاضر اجتماعات منتدى المستقبل، ما زال حبرها جميعا لم يجف بعد، مثلها في ذلك مثل إعلانات ومستندات قنوات الدعم المالي الهائل التي أنشأت بمقتضاها.
لقد كان أفضل إنجاز لهذا التحول المؤقت في الحديث الدولي عن الإصلاح في العالم العربي، هو في ممارسة الدور الكابح –بشكل مؤقت- ومن وقت لآخر، للقبضة الأمنية في بعض البلدان مما أدى –بشكل مؤقت أيضا- لتوسيع الهامش السياسي المتاح للجدل العام، وللاحتجاج في الشارع (مصر فقط) ووسائل الإعلام لفترة قصيرة. وعندما طوى المجتمع الدولي أوراقه وأدار ظهره، عادت القبضة الأمنية لتمارس سطوتها التي لا يحدها سقف، وجرى «تحرير» الشارع من حركات الاحتجاج، لتقتصر على بعض الصالونات ووسائل الإعلام. ولكن ليس هناك ضمانة لعدم محاصرة حتى ذلك الهامش المحدود، وتحجيمه أكثر، أو القضاء عليه تماما.
إن «نموذج تونس» يلخص بعمق قيمة المبادرات الدولية للإصلاح، فتونس هي الطفل المدلل للاتحاد الأوروبي –قبل وبعد الدعاوى الدولية للإصلاح- وهى «العنوان» الذي اختارته الولايات المتحدة كمقر لإدارة مبادرتها لدمقرطة العالم العربي. وخلال العامين اللذين شهدا صخب «الحديث» الدولي عن الإصلاح، لم تتوقف قبضة الدولة البوليسية لحظة واحدة عن ممارسة القمع العنيف، حتى خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمعلومات! بل قامت الحكومة بتجميد الدعم المالي الأوروبي لأبرز منظمات حقوق الإنسان في تونس، دون رد فعل أوروبي أو أميركي يتناسب ومدى الإهانة أو شراسة القمع!. ولذا ربما لم يكن مثيرا تماما للدهشة، أن تعتبر الخارجية الأميركية التعديلات الدستورية الجديدة في مصر، التي تستهدف ترسيخ أركان الدولة البوليسية وحماية ممارساتها بالدستور، بأنها خطوة على طريق الإصلاح! أو أن يباركها الاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر، عندما يحصر انتقاده لها بسرعة تمريرها في البرلمان، دون أن يعلق بكلمة واحدة على أكبر تدهور تشريعي ودستوري يجري في مصر، منذ الدستور الأول لحركة يوليو 1952!
إن أفضل تعبير عن مدى خواء المشروع الأميركي لدمقرطة العالم العربي، هو أن الدولة التي راهن عليها هذا المشروع لقيادة التحول الديمقراطي في المنطقة، أي مصر، هي نفسها التي قادت ببراعة هجومًا مضادًا ومُنظمًا على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتحولت هي نفسها من خلاله إلى دولة أكثر قمعية واستبدادًا، مما كانت عليه عند تدشين المشروع الأميركي!
نشر هذا المقال بجريدة الحياة
Share this Post