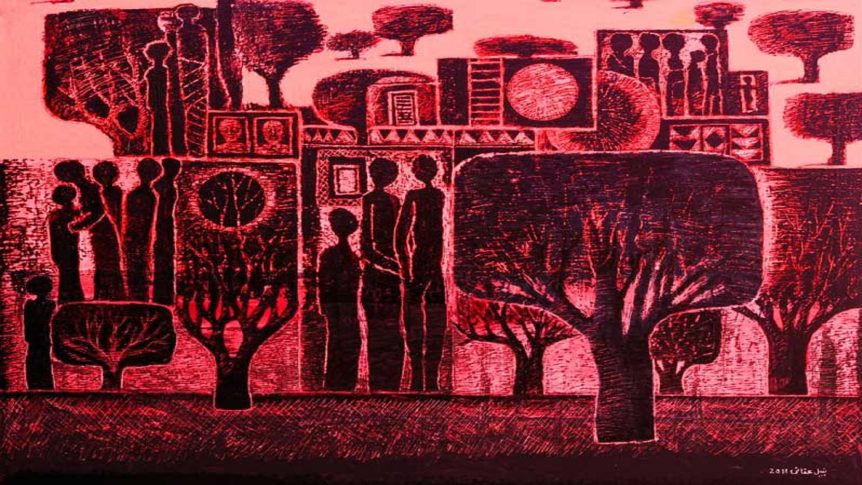بهي الدين حسن
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانأثارت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تتوعد الشعب الفلسطيني في غزّة بالتطهير العرقي وامتلاك أميركا غزة، ردود فعل دولية وعربية وفلسطينية ساخطة ومنددة، من دون أن يصدر عن أي طرف فلسطيني أو عربي أو دولي تصوّر جاد لكيفية مواجهة هذه التصريحات، يتجاوز استنكارها، قبل أن تنتقل لمجال التطبيق العملي؟
اعتبرت أطراف أميركية وغير أميركية هذه التصريحات مزاحا ثقيلا، أو لا تكمن خلفها إرادة جادّة لتطبيقها. قال بعضهم إن ترامب المناور البارع يستهدف أهدافا أخرى في تصريحاته، ربما مثل قراراته بفرض رسوم جمركية باهظة على بعض السلع المستوردة من كندا والمكسيك، والتي تراجع عنها بمجرد تعهد الدولتين بتعزيز رقابتهما على حدودهما مع الولايات المتحدة الأميركية. عززت احتمال عدم جدية التصريحات التي تتعلق بغزة محاولات بعض المسؤولين في البيت الأبيض التنصل منها في اليوم التالي من خلال تقديم تفسيرات مبتسرة لها.
أحد العوامل التي ترجح جدية المشروع الترامبي لغزّة أن الالتزامات التي وضعها لنفسه في ما يتعلق بالمسألة الإسرائيلية/ الفلسطينية خلال فترته الرئاسية الأولى (2017 – 2020)، قد أوفى بها تماما. فقد نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، واعترف بأن الجولان السورية المحتلة جزء من إسرائيل، وأقنع أربع دول عربية، رغم ذلك كله، بالتطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية وعسكرية معها. بينما فشل ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى في قضايا دولية ومحلية أكثر أهمية، كانت في مقدمة جدول أعماله، الأمر الذي ساهم في فشله في الانتخابات الرئاسية التالية عام 2020 أمام المرشح المنافس الرئيس السابق جو بايدن. عامل آخر يرجح جدّية المشروع الترامبي، أن زوج ابنته المقال جاريد كوشنر الذي أشرف على تنسيق اتفاقيات أبراهام في العقد الماضي، هو الأب الأصلي لمشروع ترامب لغزّة، وعلى الأرجح سيكون المقاول الذي سيعهد إليه بمقاولة تنفيذه حال التحرّك في هذا الاتجاه، فقد كان كوشنر أول من تحدّث علنا منذ نحو عام عن القيمة الاستثمارية الهائلة لإقامة منشآت سياحية على ساحل غزّة، في الوقت الذي كانت فيه حرب الإبادة جارية بدأب لا يرحم.
يرجّح عامل ثالث جدّية المشروع، وهو أن العالم العربي (منطقة وديناميكية حكم في كل دولة على حدة وفاعلية شعوب)، هو في أضعف لحظاته منذ هزيمة يونيو (1967). والفلسطينيون بالتأكيد هم الطرف الأكثر هشاشة، فهم لا يملكون دولة ولا قيادة موحدة ولا توافق على مشروع وطني مدروس يتجاوز الأماني المشروعة بالحقّ في تقرير المصير التي يقرها القانون الدولي. هذه الهشاشة قد تفسر أنه في اليوم التالي لإعلان المشروع الترامبي وقبل عودة نتنياهو لإسرائيل أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي توجيها لجيشه بإعداد خطة تسهل مغادرة الفلسطينيين غزة بحرا أو جوا لمن يرغب منهم. هذا مؤشّر رابع يرجّح جدية المشروع الترامبي، وجوهره إخلاء غزّة من الفلسطينيين، بصرف النظر عن جنسية القوة المسلحة التي تشرف على الترحيل، وعن اسم دول اللجوء. ويدلنا قرار وزير الدفاع على طبيعة توزيع الأدوار الذي جرى الاتفاق عليه بين ترامب ونتنياهو في الغرف المغلقة بعيداً عن المؤتمر الصحافي الصاخب. وقد جرى الثلاثاء الماضي تقديم مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي بصرف إعانة مالية مناسبة لكل فلسطيني يقرّر مغادرة غزّة. بينما اقترح رئيس أحد الأحزاب اليمينية المتطرّفة (وزير سابق في حكومة نتنياهو)، إنشاء وزارة إسرائيلية جديدة “للهجرة الطوعية”، على الأرجح سيشمل نطاق عملها الضفة الغربية أيضا. بالتوازي، يستعد الكونغرس الأميركي لمناقشة مشروع قانون باستبدال اسم الضفة الغربية بالاسم الإسرائيلي لها: يهودا والسامرة. لاحقا كشف دبلوماسي إسرائيلي في تصريحات إلى شبكة سي بي إس نيوز عن أن وجهات ترحيل الفلسطينيين لم تعد تقتصر على مصر والأردن، بل أضيفت إليهما ثلاث وجهات أخرى؛ المغرب ومنطقتان في شرق أفريقيا على حواف الصومال: بونتلاند وأرض الصومال (صوماليلاند). تصريح نتنياهو الساخر الذي يضم السعودية لقائمة الدول المقترحة لاستقبال الفلسطينيين المهجّرين قسريا هو تأكيد لا لبس فيه أن الترحيل صار في مقدمة جدول الأعمال على حساب أولويات أخرى كانت تبدو أهم كثيرا، حتى لو أدّى ذلك إلى تأجيل تطبيع العلاقات مع السعودية.
ليست هذه بدايات النكبة الثانية، بل مؤشرات قاتمة جدا إلى طبيعة خواتيمها. مع ذلك، ما زال معلقون عرب يملكون ترف المجادلة حول من هزم في غزّة؟! هذه إحدى الملامح الخاصة جدا التي تميز النكبة الثانية عن الأولى (1948). أعني حالة الغيبوبة المهيمنة على عقول قطاعات رئيسية في النخب السياسية العربية، بمن فيها الفلسطينية، والتي تعميها عن حجم المأساة الإنسانية في غزّة ومدى قسوتها، وعن مغزى حجم الخسائر النوعية العسكرية والبشرية في حركة حماس وفي صفوة قادتها السياسيين والعسكريين، وحجم الإفلاس السياسي العربي علي الصعيدين الحكومي والشعبي، حتى بالمقارنة بديناميكية التضامن السياسي من بعض شعوب دول الغرب، بل ومن بعض حكومات هذه الدول ضد حرب الإبادة.
التعلق بالأماني ممكن دائماً ومفيد أحيانا في تحسين معنويات الفرد والجماعة، وهو بحد ذاته دافع حيوي للإنجاز على صعيد الأفراد والجماعات، ما لم يتحوّل إلى مخدر، وهدف بحد ذاته بديل عن الفعل. العقبة الحقيقية أن هذه الأماني لا تجد إرادة سياسية كافية، فلسطينية أو عربية أو دولية، لإنفاذها، فبدلا من العمل التراكمي الشاق على بناء هذه الإرادة على كل الأصعدة، بدءا بالقاطرة، أي المحور الفلسطيني، جرى الانزلاق إلى إغراء خيار المقاومة المسلحة حلاً سحرياً لمعضلة اختلال علاقات قوى، وحتى لو لم يكن هذا الحل يحظى بالتوافق الدولي ولا العربي ولا حتى الفلسطيني، وحتى لو مورس بطرق ووسائل قد تعرّض للخطر الروافع الأهم لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني، أي تلك المتصلة بالدعم الأخلاقي والقانوني لهذا الكفاح المرير في ظل موازين قوى محلية وإقليمية ودولية لا تعمل لصالحه. لم ينحصر انتقاد عملية طوفان الأقصى بنتنياهو وداعميه في بعض دول الغرب، بل امتد ليشمل المحكمة الجنائية الدولية (أحد أهم مرتكزات العدالة الدولية التي تشكل الرافعة الأخلاقية الرئيسية للقضية الفلسطينية). كما شنت السلطة الوطنية الفلسطينية هجوماً سياسياً لا يقل ضراوة على عملية “طوفان الأقصى”، فضلا عن أن العملية لم تحظ بتأييد لاحق من الحكومات العربية. يمكن بالطبع تأليف مجلدات موثقة في انتقاد السلطة الوطنية الفلسطينية في عهدي ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس أبو مازن، ولكن ليس من أحدٍ يستطيع أن يقدم تفسيرا عقلانيا واحدا لاستحالة التنسيق والتفاهم بينها وبين حركة حماس قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (2023) أو بعده، أو لأسباب صمود كل الاتفاقيات بين إسرائيل وكل من الطرفين على حدة خلال الفترة نفسها، وجديدها أخيراً اتفاق وقف إطلاق النار الأول بين إسرائيل وحماس العام الماضي والمرحلة الأولى من الاتفاق الجديد. بينما لم يصمد اتفاق واحد بين السلطة الوطنية وحركة حماس خلال ثلاثة عقود، رغم أن الوسيطين العربيين شاركا في الوساطتين في المسارين، وانضم إليهما آخرون في بعض المحطات، من الجزائر وروسيا والصين؟!
الوجه الآخر لعملية طوفان الأقصى أنها كشفت بوضوح فاضح عن مدى تصدّع الجبهة السياسية الفلسطينية العربية المرشحة للمساندة. وبالتأكيد، لم يبدأ هذا التصدّع في عملية طوفان الأقصى التي استخدمها نتنياهو لتبرير حرب الإبادة، لكن لا شك أن القوس الذي فتحته هذه العملية تغلقه حالياً وعود ترامب المشؤومة.
تلقي هذه التطورات بمسؤوليات تاريخية هائلة على النخب السياسية الفلسطينية، خاصة التي تتمتع باستقلالية عن كبرى الفصائل العسكرية (فتح وحماس). لقد انتزعت الفصائل العسكرية الفلسطينية المبادرة من النخب المدنية الفلسطينية بعد الهزيمة المروعة في 1967 للجيوش النظامية العربية. مع ذلك، حافظت النخب المدنية الفلسطينية على حيويتها واستقلاليتها السياسية حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولي في ثمانينيات القرن الماضي، التي كانت أهم العوامل التي دفعت إسرائيل إلى التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاق أوسلو، بالاستفادة من تأثير فقدان المنظمة لآخر قواعدها المسلحة في دول لها حدود مشتركة مع إسرائيل.
في هذا السياق، توصل منذ تسعينيات القرن الماضي محللون أكاديميون (مثل الفلسطيني يزيد صايغ والمصري محمد السيد سعيد)، إلى أن الكفاح الفلسطيني المسلح كاستراتيجية فقد جدواه، رغم تسليمهم بالحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وحثوا على ضرورة تطوير استراتيجية وطنية جديدة لتحقيق الأهداف المشروعة نفسها.
وضعت حركة فتح وشقيقاتها من الفصائل الفلسطينية المسلحة منذ ستة عقود استراتيجية الكفاح الوطني الفلسطيني في عالم مختلف تماما. كان عالماً ثنائي القطبية، تمتعت خلاله المقاومة الفيتنامية بدعم غير محدود من الاتحاد السوفييتي (السابق) والصين الماوية، وكانت الأحزاب الشيوعية المساندة لفيتنام وفلسطين تنافس على الحكم في عدة دول أوروبية. بالتوازي، كان الكفاح الفلسطيني يتلقى الطعنات من حلفائه الوهميين في البعث السوري والعراقي (ركيزتي ما عرف باسم جبهة الصمود والتصدي)، حيث جري اغتيال بعض أبرز الرموز الفلسطينية واللبنانية على أيدي تنظيمات تلقت رعاية الحزبين، فضلا عن تنظيم مذابح في مخيمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان. استبدال “جبهة الصمود والتصدي” البائسة بما سمي “محور الممانعة” بحثا عن سبل لإعمال استراتيجية فقدت مقوماتها، لم يؤدِّ إلى نتائج أقل بؤسا، بل وأدّى إلى تلطيخ اسم الكفاح الوطني الفلسطيني بالتحالف مع نظم حكم فاشية ودموية في إيران وسورية، ومع حزب الله الذي ساهم في القمع المسلح بأبشع الوسائل للشعبين السوري واللبناني، ومع الحوثيين الذين يسعون إلى إعادة اليمن إلي حكم وأحكام القرون الوسطى. تكرار الانزلاق للتحالف مع بعض أبشع جلادي الشعوب العربية وغير العربية في سياق جبهة الصمود والتصدي ثم محور الممانعة تحت لافتات قضايا تلهث من أجل الدعم الأخلاقي لها، مثل التحرّر الوطني الفلسطيني ومواجهة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والإمبريالية مسألة جديرة بالتأمل واستخلاص الدروس.
لقد ذهب العالم الذي شهد ميلاد استراتيجية الكفاح الوطني الفلسطيني في القرن الماضي، وحلّ محله عالم آخر بدأ يتبلور منذ أوائل القرن الجديد. عالم أحادي القطبية، لا يتورّع الرئيس الأميركي فيه عن الإفصاح عن تطلعات استعمارية، ليس في غزّة فحسب، بل في كندا وبنما والدنمارك. من أبرز المتغيرات أيضاً أنه بينما استثمرت إسرائيل في انتصارها الهائل على جيوش أكبر الدول العربية عام 1967، وصارت على رأس أقوى دول منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أبرز الدول الصناعية، صارت أكبر دولة عربية (مصر) أكبر دولة متسوّلة للمعونات، وصارت المنطقة العربية أكثر ضعفا وهشاشة واستبدادا مما كانت عليه في الرابع من يونيو/ جزيران 1967.
حين شنّت حركة فتح عمليتها المسلحة الأولى قبل 60 عاما، لم تكن إسرائيل تحظى باعتراف دولة عربية واحدة، بينما تحظى حالياً بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية غير متكافئة مع ست دول عربية على الأقل. خلال فترة وجيزة، ستجري موجة تطبيع جديدة، وقد أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبّون أخيراً، أنه سيطبّع العلاقات مع إسرائيل حال إنشاء دولة فلسطينية.
هذه متغيرات هائلة تتحدّى العقل الفلسطيني، لا تتطلب فحسب إعادة النظر في استراتيجية جرى وضعها لعالم مختلف: دوليا وعربيا وفلسطينيا، بل تتطلب، من أجل إجراء مراجعة جادّة ورشيدة لها ووضع استراتيجية بديلة وفعالة، أن تستعيد النخب المدنية الفلسطينية السياسية والثقافية والتكنوقراطية زمام المبادرة.
المصدر: العربي الجديد
Share this Post