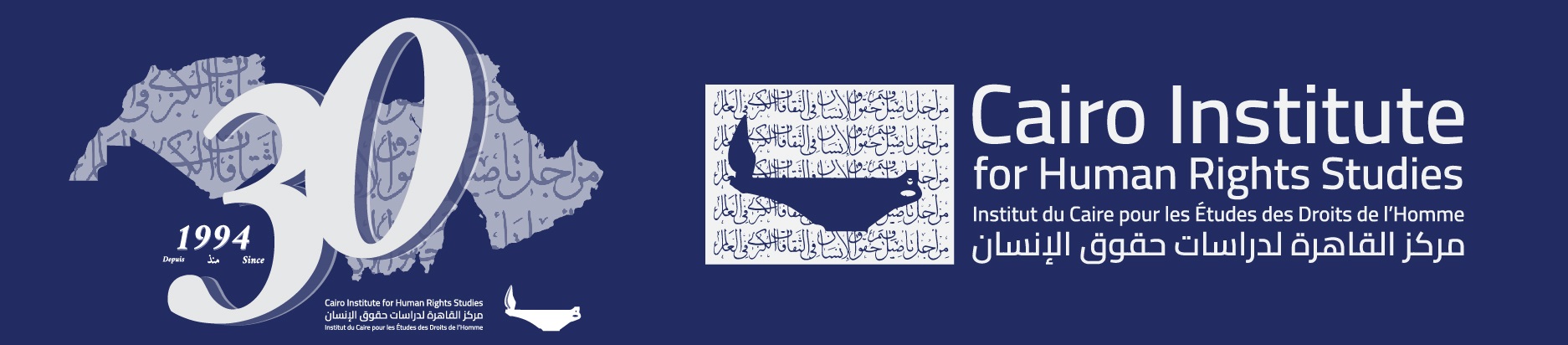حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع ويتعين أن يتمخض عن تصرف إرادي حر لا تتدخل فيه الجهة الإدارية ويستقل عنها”.
بتلك العبارات أعلنت المحكمة الدستورية العليا انحيازها الصريح لحق الجمعيات الأهلية في ممارسة أنشطتها بحرية وباستقلال بعيدا عن أشكال الوصاية والهيمنة التي تمارسها الحكومة على العمل الأهلي، عبر سلسلة من التشريعات المتتالية التي ظلت –ولا تزال- تمارس دورها المقيت في محاصرة العمل الأهلي، وتفتح مجالا واسعا للتدخلات التعسفية من قبل الحكومة، ليس فقط في الترخيص بإنشاء الجمعيات، بل في سلب اختصاصات أعضاء أي جمعية وصلاحيات مؤسسيها وهيئاتها المنتخبة، سواء في وضع نظامها الأساسي أو تعديله، أو في طرائق إدارة عملها اليومي ونظام عقد اجتماعات هيئاتها القيادية، وقواعد انتخاب تلك الهيئات، وحق الجمعية العمومية في اختيار من تراه لعضوية هذه الهيئات، بل وحق هذه الجمعيات في الدخول في ائتلافات أو اتحادات أو شبكات، سواء على المستوى الوطني، أو على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن التحكم في الترخيص لهذه الجمعيات، وفي جمع التبرعات أو الحصول على منح خارجية تدعم مشروعاتها وأنشطتها، ناهيك عن إطلاق يدها في حل أي جمعية أو حل مجلس إدارتها، أو تجميد بعض أنشطتها، دون أن تتاح الفرصة لأعضاء الجمعية في تصحيح الأوضاع التي تدفع بجهة الإدارة إلى مثل هذه التدخلات الفجة، التي تؤول إلى الموت البدني للجمعية، بما ينطوي عليه مثل هذا الإجراء من عقاب جماعي لأعضاء الجمعية، وكل المستفيدين من رسالتها.
كان ذلك حال القانون رقم 153 لسنة 1999، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في غضون شهور قلائل من صدوره، والذي خاضت منظمات حقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الأهلية معارك ضارية في مواجهته على مدى عامين، اشتبكت خلالها مع المسودات المتتالية للمشروع، وفضحت مرامي المشروع وأوجه العوار الدستوري الذي تعتريه، مثلما فضحت أيضا محاولات الحكومة للإيحاء بأن القانون جرى صياغته بصورة ديمقراطية في إطار من الحوار والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة بعد أن انتقت وزارة الشئون الاجتماعية في ذلك الوقت عددا من رموز العمل الأهلي وضمتهم إلى لجنة “وهمية” للصياغة، باعتبارهم ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، ثم قدمت الحكومة مشروعا آخر للبرلمان!
ومع ذلك فإن القانون الحالي قم 84 لسنة 2002، والذي حل محل القانون 153 لسنة 1999، جاء نسخة طبق الأصل من ذات القانون الذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا.
التعديلات تتجه إلى الأسوأ:
لقد كانت –ولا تزال- منظمات حقوق الإنسان تسعى وتتطلع إلى تشريع جديد، يعزز حرية العمل الأهلي واستقلاليته في ضوء المعايير الدولية المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية، وفي ضوء المبادئ والمعايير التي شارك في وضعها وصياغتها نشطاء المجتمع المدني، سواء على المستوى الإقليمي أو في مصر، أو حتى باحترام نصوص الدستور المصري، الذي لم يضع حظرا على حرية إنشاء وتأسيس الجمعيات سوى تلك التي يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع، أو سريا أو ذات طابع عسكري.
ودعت هذه المنظمات مرارا إلى الاحتكام إلى مواد القانون المدني، التي أجهزت عليها حقبة يوليو، واستعاضت عنها بسلسلة القوانين المشبوهة، ابتداء من القانون 32 لسنة 1964، ووصولا إلى القانون الحالي، وجميعها يكرس فلسفة الوصاية والهيمنة والإلحاق بمؤسسات المجتمع المدني بأجهزة السلطة التنفيذية.
والآن، فإن الحكومة تتجه إلى تعديل القانون الحالي، وبنوايا معلنة لإحكام الخناق على هامش الحرية المحدود الذي تتحرك فيه مؤسسات المجتمع المدني، سواء في إطار القانون أو حتى بالالتفاف على بعض أحكامه بالغة التعسف.
نقول ذلك ليس فقط من خلال المعلومات المحدودة التي تتسرب حول التعديلات المقترحة، وليس فقط لأن الحكومة قد ارتأت هذه المرة أن تتحرر تماما من ذلك السيناريو الهزلي، الذي أدارت به مسرحية “الشراكة” مع مؤسسات المجتمع المدني في إعداد قانونها رقم 153 لسنة 1999، واكتفت هذه المرة بزعمها مشاركة بعض قيادات المجتمع المدني، فيما تسميه بـ “لجنة الحكماء”؟.
فالأهم من ذلك أن الشروع في تعديل القانون يأتي وسط أجواء لم يعد خافيا فيها على أحد، أن الحكومة تتجه وبصورة حازمة نحو الإجهاز بصورة كلية على مختلف أشكال الحراك السياسي والمجتمعي، مدعومة في ذلك باستمرار الاختلال الفادح في موازين القوى لصالحها في الداخل في مواجهة القوى المتطلعة للديمقراطية والحرية والإصلاح، من جانب، ويقترن بذلك من جانب آخر بتراجع للضغوط الخارجية التي انطلقت بدعاوى مقرطة العالم العربي وباسم محاربة الإرهاب.
وقد تجلت هذه الإرادة السياسية للانقضاض على هوامش الحرية تجسيدها خلال العامين الأخيرين، في الصدام مع الجماعة القضائية وناديهم، والتوسع في استخدام قانون الطوارئ وقانون الأحكام العسكرية في ملاحقة الخصوم، وتقديمهم للقضاء العسكري الاستثنائي، وفي الإجهاز على الضمانات الدستورية للحرية والأمان الشخصي، والضمانات التي تحمي حرمة المنازل والحياة الخاصة، وضمانات المحاكمة العادلة والمثول أمام القضاء الطبيعي، عبر التعديلات الدستورية الأخيرة، وفي التنكيل بالصحافة الحزبية والخاصة عبر سلسلة متلاحقة من أحكام الحبس، لم تعرفها مصر من قبل، وطالت في غضون شهر واحد تقريبا خمسة من رؤساء تحرير تلك الصحف والعديد من الصحفيين فضلا عن رئيس حزب معارض بسبب ما نشرته صحيفته.
وفي ذات الإطار أجهزت الحكومة في غضون الشهور القليلة الماضية على مؤسستين حقوقيتين بارزتين، وهى دار الخدمات النقابية والعمالية، التي تأسست قبل نحو 17 عاما، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1994.
وإذا انتقلنا إلى ما هو متاح من معلومات بشأن التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على القانون الحالي، يبدو واضحا للعيان أن التعديلات تبقي بصورة كاملة على مختلف النصوص التي تكرس الهيمنة على العمل الأهلي، ولكنها تضيف إلى ذلك:
1- نزعة أكثر تشددا تجاه أية أشكال للتنظيم القانوني للجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، التي لا تنضوي تحت مظلة قانون الجمعيات، وهو ما يشير بوجه خاص إلى المنظمات التي نشأت كشركات غير هادفة للربح، سواء كانت شركات للمحاماة أو للبحوث أو للاستشارات أو الصحة أو غيرها، حيث تتجه النية في التعديلات المقترحة إلى أن أي جماعة يدخل في أغراضها نشاط الجمعيات، يتعين عليها توفيق أوضاعها في إطار قانون الجمعيات، حتى لو اتخذت شكلا قانونيا آخر، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون. ويضيف التعديل المقترح هنا “ويمتنع على أي جهة تسجيل هذا الكيان وحل المسجل منها”.
2- لا تكتفي التعديلات المقترحة بالإبقاء على نظام الترخيص المشروط في إنشاء الجمعيات وما يقترن به من قيود إجرائية وتعسفية، بل إن هناك توجه أكثر تعسفا، وذلك بالتخفف من التزام الحكومة –طبقا للقانون الحالي- بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد، حتى لو كان لديها اعتراض على النظام الأساسي أو بعض مؤسسي الجمعية.
3- النزوع إلى تقليص حق الجمعيات في اختيار مجالات عملها وحصرها في ثلاثة ميادين فقط، بل وقيد حق المؤسسات الأهلية في إدراج الأنشطة في نظامها الأساسي بمدى تناسب حجم المال المخصص لهذه المؤسسة مع هذه الأنشطة، وهو ما يضفي صعوبات مستقبلية على إمكانية تعديل نظامها الأساسي وإدراج أنشطة إضافية، إذا ما نجحت في تدبير الموارد اللازمة لها.
4- التلويح باستدعاء بعض مواد القانون 32 لسنة 1964 سيئ السمعة، التي تفاخرت الحكومة من قبل باستبعادها في القانون الحالي، من قبيل حظر إنشاء جمعيات بعينها، إذا كانت هنالك جمعيات قائمة في ذات النطاق الجغرافي تقوم بأنشطة مماثلة لما تعتزم الجمعيات الجديدة إدراجه من أنشطة في نظامها الأساسي.
5- لا تكتفي التعديلات بالإبقاء على صلاحيات الحكومة التدخل الواسع في تفاصيل العمل اليومي للجمعيات، بل تمنح صلاحيات إضافية للاتحاد العام للجمعيات، تحوله لأن يكون ممثل الحكومة ورقيبها في عدد من الإجراءات التي يتعين بموجب التعديلات أخذ رأيه فيها، بل وألزمت الجمعيات بأن تفيد الاتحاد بالقرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
6- تضيف التعديلات مداخل أكثر تنوعا لمحاصرة الجمعية بعقوبات إضافية تصل إلى إيقاف النشاط، وحرمان أعضاء مجلس الإدارة من الترشيح لدورتين متتاليتين، وذلك إذا ما امتنعت الجمعية عن تمكين جهة الإدارة بمراجعتها، وإذا انتقلت إلى مقر جديد من دون أن تخطر الإدارة.
7- تفتح التعديلات بابا واسعا لاختراق الجمعيات وإغراقها بعضويات يمكن أن تلعب دورا مناوئا لرسالة الجمعية، أو لصالح أجهزة الأمن، مستفيدة من خبرات الحكومة التونسية في تقويض المنظمات المستقلة من داخلها، وذلك من خلال حظر الأخذ بنظام العضوية المغلقة في أي جمعية.
ما العمل في مواجهة الهجمة التشريعية الجديدة؟
ندرك أنه حتى في أكثر التحليلات تفاؤلا فإن الفرصة غير سانحة بالمرة لإحداث قطيعة حقيقية مع فلسفة الهيمنة والإلحاق التي كرستها قوانين الجمعيات المتلاحقة. وفي أحسن الأحوال فإن منظمات حقوق الإنسان والقوى المتطلعة لتعزيز دور المجتمع المدني، ينبغي أن تعمل معا لقطع الطريق على مزيد من الوصاية والهيمنة على مقادير العمل الأهلي، دون تكريس فلسفتها والترويج لها.
كما ينبغي التخفف من الأوهام التي قد تبدد طاقات الكثيرين في ممارسة نوع من الضغوط، لحفز وزارة التضامن الاجتماعي على إدارة حوار أو الدخول في نوع من الشراكة الزائفة، حول تعديل القانون لن تقود عمليا إلا إلى إضفاء المشروعية على المخطط الحكومي لتطويق العمل الأهلي، على النحو الذي جرى خلال الحوار حول تعديل المادة 76 عام 2005، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي انتهى الحوار حولها إلى اعتماد ما سبق “طبخه”، مع تجميله بتقديمه باعتباره نتاجا “لحوار وطني”.
ولذا، ربما يكون من صالح المجتمع المدني، وكذلك الشخصيات -التي تحاول من خلالها الحكومة أن توحي للرأي العام بأن المجتمع المدني يشارك في وضع التعديلات- أن يبادروا بالانسحاب من تلك اللجنة المزعومة، وأن يعلنوا صراحة للرأي العام موقفهم من الجريمة التي يخطط لها باسمهم داخل الغرف المغلقة، على نفس النحو الذي سبق تمريره في قانون الجمعيات الأهلية 153 لعام 1999، وكذلك في التعديلات البائسة التي أدخلتها الحكومة على قانون الأحزاب، قبل أكثر من عامين، وادعت أنها نتيجة لحوار أحزاب المعارضة مع الحزب الحاكم.
إن فرص درء المخاطر المحدقة بالعمل الأهلي أو قطع الطريق على بعضها، يقتضي التمسك الصارم أكثر من أي وقت مضى بالأسس والمبادئ التي تكفل حرية العمل الأهلي واستقلاليته، والتمسك بالمعايير الدولية المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية، لضمان حرية تكوين الجمعيات، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى فضح الفلسفة والأسس التي يقوم عليها القانون برمته، بما في ذلك التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على هذا القانون. كما أن التخلي عن المعايير الدولية لحرية التعبير والحق في التجمع وفي تكوين منظمات غير حكومية، لا يفيد إلا في المساهمة في تعبيد الطريق أمام مشروع قانون لخنق المجتمع المدني. إن المستفيد الوحيد من حسن النوايا والطوايا في هذه المناسبات، هم الذين أنهوا مشروعهم لخنق منظمات المجتمع المدني، ويبحثون فقط عن الوقت المناسب لتمريره وسط زفة “ديمقراطية” زائفة.
إن منظمات المجتمع المدني لا تبدأ من فراغ، فعبر سنوات طويلة من العمل المتواصل في مواجهة القيود القانونية على العمل الأهلي، نجحت في بلورة الأسس والمبادئ التي تؤمن استقلالية العمل الأهلي وديمقراطيته، ولديها من الدراسات القانونية ما يكفي، فضلا عن مشروع قانون بديل للجمعيات الأهلية سبق أن تبناه بعض أعضاء البرلمان.
إن إحداث قطيعة مع الفلسفة التي تكرس الهيمنة على القطاع الأهلي، هى معركة طويلة الأمد تمليها مسئوليات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وبينها حق تكوين الجمعيات، وفقا للأسس والمعايير العالمية.
فلتكثف منظمات المجتمع المدني جهودها من أجل فضح المؤامرة التشريعية الجديدة على أوسع نطاق، ولتسعى لكسب قطاعات أوسع من الرأي العام، داخل القوى والأحزاب السياسية –بما في ذلك الحزب الحاكم- ومن بين صفوف البرلمانيين والمنابر الإعلامية المستقلة والمعارضة والحكومية.
ولتسعى أيضا لاستثمار مختلف الآليات الدولية والإقليمية المتاحة، في البرهنة على استخفاف الحكومة بالالتزامات والمعايير الدولية، التي تزعم القبول بها، ولتسعى إلى حفز مزيد من تضامن المنظمات الدولية، والمجتمع المدني العالمي في التصدي لتلك الهجمة.
الورقة من إعداد: عصام الدين محمد حسن: باحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورئيس تحرير مجلة “سواسية”.
Share this Post