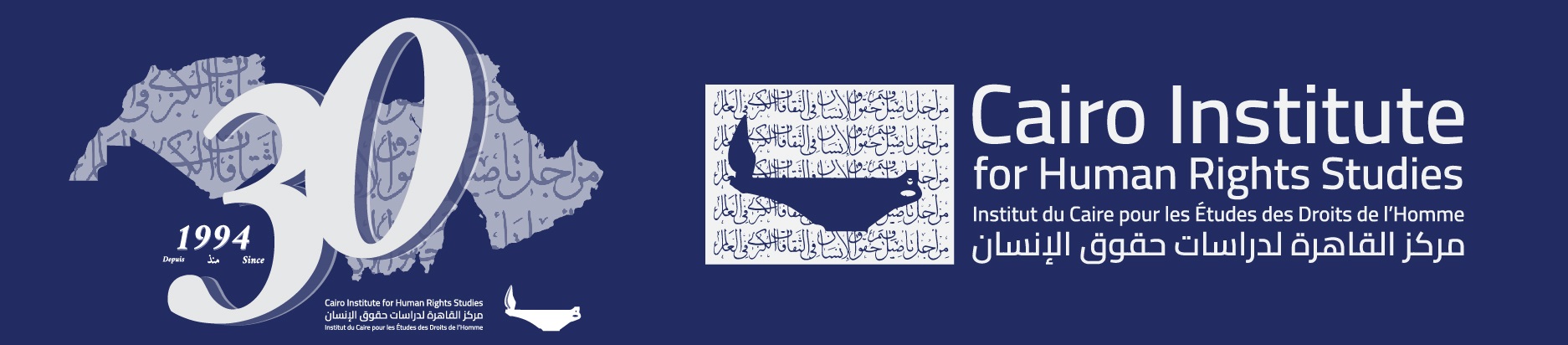ورقة موقف
(مارس – يونيو 2021)
منذ عودة احتجاجات «الحراك» المؤيدة للديمقراطية في فبراير 2021، وقبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر انعقادها في 12 يونيو الجاري؛ صعّدت الحكومة الجزائرية قمعها بحق المعارضة السلمية والجهات الفاعلة المستقلة بشكل واضح، لا سيما الصحفيين والمتظاهرين وعددًا من أعضاء السلطة القضائية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
قمع الاحتجاجات أبرز حجم الافتقار للحريات العامة الأساسية باعتبارها الضمانة الأساسية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وكان هذا التصعيد متوقعًا، استنادًا لحملات قمع مماثلة سابقة لجات لها الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء الدستوري في نوفمبر 2020. إلا أن حدة التصعيد على مدى الشهرين الماضيين بدت مختلفة؛ الأمر الذي يعكس رغبة الحكومة العارمة في حجب كافة أشكال النقد، وعودة الوضع لما قبل فبراير 2019.
ورغم أن الاحتجاجات الشعبية المتواترة، ومحاولات قمعها، لم تؤد سوى لحصار سياسي غير مثمر، إلا أن فبراير 2019 شكل نوعًا من التحرر في الوعي السياسي الجزائري، لا يمكن الرجوع عنه. فإذا لم يتراجع النظام الجزائري عن ممارسات العنف السياسي واستخدامه للقوة –كما فعل في الماضي– فهذا قد يثير انتباه وتحفظ المجتمع الدولي، الذي أولى اهتمامًا ضئيلًا بالحراك منذ بدايته وحتى الآن.
وبغض النظر عن الحراك، فإن احتمالات العودة لما قبل فبراير 2019 باتت غير مؤكدة، في مقابل الوضع الاقتصادي المثير للقلق، والذي ضاعف من الاضطرابات الاجتماعية، في المناطق الجنوبية الغنية بالموارد؛ فأضعف موقف المؤسسة العسكرية الحاكمة، في ظل عدم إظهارها أية بوادر تبرهن على إرادة سياسية للانخراط في إصلاحات حوكمة هيكلية.
- استمرار مساعي إسكات كافة أصوات المعارضة
في 18 فبراير، وفي أعقاب عودته من رحلة علاجية امتدت لثلاثة أشهر في أحد مستشفيات ألمانيا، أعلن الرئيس الجزائري عفوًا رئاسيًا عن 30 شخصًا على الأقل من المحتجزين بسبب مشاركتهم في الحراك. كانت احتجاجات جديدة تلوح في الأفق عشية الذكرى السنوية الثانية للحراك؛ فجاءت لفتة الترضية النادرة تلك، إلا أن أثرها لم يمتد طويلاً؛ ففي 11 مارس، أعلنت السلطات إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وسط تصعيد كبير في قمع الاحتجاجات والمعارضة السلمية.
في 12 مارس، ارتفعت وتيرة العنف بحق المتظاهرين، وتعدد الاعتداءات والانتهاكات العنيفة في مختلف أنحاء البلاد. ففي الجزائر العاصمة، اعتدت مجموعة من الأفراد بدنيًا ولفظيًا على 8 صحفيين، فيما بدا في البداية وكأنه هجوم يستهدف الصحفي عبد القادر كاملي، من فرانس 24. وقد وردت إفادات تشير للتعرف على الجناة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنهم سبق واخترقوا المظاهرات مرددين شعارات رافضة لـ «التدخل الأجنبي» ومشاركة النساء في الاحتجاجات. وبدلاً من تحقيق لم يبدا بعد في واقعة الاعتداء، أصدر وزير الإعلام في 13 مارس «تحذيرًا أخير» لفرانس 24، متهمًا إياها بتقديم تغطية إعلامية كاذبة وتخريبية. وبشكل عام، تصاعدت الاعتداءات البدنية بحق الصحفيين الذين تعرقل السلطات لعملهم بشكل متواصل؛ مما تسبب في إحجام بعضهم عن تغطية الاحتجاجات خارج الجزائر العاصمة. ففي 14 مايو، تم اعتقال 18 صحفيًا على الأقل، من بين 1000 شخص تم اعتقالهم في اليوم نفسه في سياق قمع الاحتجاجات.
تواصل السلطات أيضًا استهداف المجتمع المدني بشكل تعسفي؛ إذ تم إخطار «الجمعية الوطنية للشباب – راج» أن وزارة الداخلية طالبت بحلها، كما حوكم أعضاء جمعية «أس. أو. أس. باب الواد» الثقافية بتهم ممارسة «أنشطة تخربيبة» والحصول على «تمويل أجنبي» –وهي تهم تصل عقوبتها للسجن من 5 سنوات إلى 24 سنة، بعد التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في أبريل 2020.
وللمرة الأولى منذ فبراير 2019، مُنعت المسيرة الطلابية الأسبوعية في الجزائر العاصمة لأسبوعين متتاليين، في 27 أبريل و4 مايو. كما شرعت الشرطة في عرقلة مسيرات الجمعة في وهران، وفي الجزائر العاصمة. وفي 7مايو، غيّر المحتجون مسار المسيرة في الجزائر العاصمة لمراوغة قوات الشرطة. فأعلنت وزارة الداخلية في 9 مايو للمرة الأولى منذ فبراير 2019، ضرورة الحصول على «تصريحات مسبقة» لتنظيم مسيرات الحراك، كما طلبت أسماء المنظمين ومسار المسيرة، وهو ما يعد في الجزائر بمثابة المطالبة بترخيص مسبق للمسيرة. بينما أنكرت وزارة الداخلية بشكل سريع في 20 مايو الادعاء بتلقيها أية «طلبات بتصريحات للمسيرات» من أفراد، ووصفت تلك المعلومات بأنها «حملة خبيثة» في رد فعل سريع على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن. فضلاً عما تداول من أنباء متزايدة حول إجبار الشرطة للمتظاهرين على توقيع تعهد رسمي مكتوب بعدم مشاركتهم في احتجاجات أخرى؛ كشرط لإطلاق سراحهم.
وفي أعقاب الاغتصاب الجماعي لتسعة مُعلمات في 17 مايو، عبرت جماعات الدفاع عن حقوق المرأة عن استنكارها لاستمرار وتفشي الإفلات من العقاب على العنف القائم على النوع الاجتماعي، في سياق تستمر فيه معاناة النساء الجزائريات جراء التمييز الشديد في أحكام قانوني العقوبات والأسرة، التي تحصرهن فيما يشبه وضع القاصر قانونيًا. هذا بالإضافة إلى مزاعم عن ممارسات تعذيب في أماكن الاحتجاز، واعتداء الجنسي على نطاق أوسع، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات الشديدة التي يواجها الضحايا والمحامين. ففي 4 و5 أبريل، اعتُقل 5 من نشطاء الحراك نشروا مقاطع فيديو للمتظاهر القاصر سعيد شطوان يتحدث خلالها عن مزاعم تعرضه للعنف الجنسي. وقد مثل النشطاء أمام النيابة دون محاميهم، ووجه لهم النائب العام اتهامات دون دليل بالتورط في الاعتداء على شطوان، ومعادية المثليين. وبثت وسائل الإعلام المملوكة للدولة هذه الاتهامات على نطاق واسع. وفي 27 أبريل، أعلنت السلطات إلحاق شطوان بخدمات رعاية الطفل، بينما مُنعت أمه من تقديم شكوى.
في 3 يونيو سجلت الجزائر ارتفاعًا مقلقًا في أعداد سجناء الرأي، ليصل 215 سجينًا بعد 32 سجين في 20 فبراير. كما تم توثيق ما لا يقل عن 6000 حالة اعتقال لمتظاهرين ونشطاء سلميين منذ 22 فبراير وحتى ويونيو الجاري، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم أقل من الفعلي للمعتقلين نتيجة الصعوبات المتعلقة بالحصول على المعلومات خارج المراكز الحضرية. وحتى وقت إعداد هذه الورقة، لم يصدر مرسوم رسمي بالعفو الرئاسي عن المعتقلين، والذي سبق وأعلن عنه الرئيس في 18 فبراير الماضي، مما أدى لالتباس فيما يتعلق بالوضع القانوني للمعتقلين المفترض أن يشملهم العفو.
وبصرف النظر عن الحراك، أسكتت السلطات الحركات الاحتجاجية الأخرى بطريقة مماثلة، ومن بينها المعلمين، وموظفي البريد، ورجال الإطفاء، ومجتمعات الطوراق التي تحتج على استغلال الأراضي، أو المتقاعدين من الجيش. ففي 3 مايو، ألقت السلطات الجزائرية القبض على 230 من رجال الإطفاء الذين تظاهروا من أجل ظروف عمل أفضل، وزعمت السلطات أن الاحتجاج كان «مؤامرة» حرضت عليها «جهات معادية للجزائر». كما واجه قادة النقابات العمالية جزاءات تعسفية ومحاكمات بسبب أنشطتهم النقابية أو لدعمهم «الحراك».
- إصلاحات تشريعية شكلية تتجاهل الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة
في ردة فعل على عودة الاحتجاجات الشعبية، حافظت السلطات الجزائرية على واجهة من الإصلاحات المؤسسية أعقاب الانتخابات الرئاسية المنعقدة في ديسمبر 2019. إلا أن العمليات الانتخابية والتغييرات التشريعية التي تديرها الدولة، وقدمتها باعتبارها أساسًا لـ «الجزائر الجديدة»؛ تتناقض بشكل حاد مع القمع المكثف المذكور آنفًا. إذ لم تمثل الإصلاحات المعلنة منذ فبراير 2019 تقدمًا جوهريًا، بل أسفرت عن انتكاسة فيما يتعلق بشروط الحكم الرشيد وسيادة القانون، بما في ذلك تعديلات قانون العقوبات في أبريل 2020، والمراجعة الدستورية في 2020، ومرسوم تنظيم الإعلام الرقمي في نوفمبر 2020. والأهم أن المطلب الأول للحراك –دولة مدنية وليست عسكرية– لم يحظ بالاعتراف حتى الآن.
فقد استخدمت السلطات المراجعة الدستورية لإضفاء الطابع الرسمي على الدور السياسي للجيش في الدستور، من خلال مقدمة المادة 30، الفقرة الرابعة، والتي تنص على أن «الجيش الوطني الشعبي يقوم بالدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد وفقًا للدستور». هذه الصيغة المبهمة، والتي تُركت مهمة تفسيرها للجيش نفسه، من شأنها السماح بتدخل الجيش السياسي فيما يعتبره تهديدًا للمصالح الحيوية والاستراتيجية. ورغم أن احتمالية انقلاب الجيش على الانتخابات بشكل صارخ تبدو ضعيفة؛ إلا أن هذا البند يجعل الدولة الجزائرية أسيرة للطابع العسكري، كما يتيح تدخل الجيش في الحياة السياسية، على سبيل المثال في حال قررت الواجهة المدنية للنظام إطلاق إصلاحات ديمقراطية حقيقية.
المراجعة الدستورية ضاعفت أيضًا من القيود التعسفية على الحقوق والحريات، والتي لم ينظر بعد بشكل كامل في تداعياتها واسعة النطاق. فبموجب المادة 34 الجديدة، يمكن فرض قيود على الحقوق والحريات؛ استنادًا لمفاهيم فضفاضة مثل «النظام العام» و«الأمن» و«الثوابت الوطنية»، دون ضمانات الضرورة والتناسب التي يفرضها القانون الدولي. وقد تمثلت أول العواقب المثيرة للقلق في قبول المحكمة العليا، في 28 مارس 2021، استئنافًا لعدم دستورية المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، على أساس المادة 34. وكانت المادة 24 تمنح للمحامين حصانة أثناء ممارسة عملهم، تحميهم من التعرض للضغوط. وفي حالة الحكم النهائي بعدم دستوريتها يتعرض حق الدفاع لتهديد خطير، علمًا بأن المحكمة الدستورية، التي من المقرر أن تنظر الاستئناف، تخضع لنفوذ الرئيس الذي يعين رئيسها وثلث أعضائها.
كانت السلطات الجزائرية قد زعمت أيضًا أن قانون الانتخابات الجديد، الذي تم إقراره بمرسوم رئاسي في مارس 2020، من شأنه تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء من خلال نظام الكوتا، ووضع نهاية للفساد من خلال نظام القائمة المفتوحة (مع عدم ترتيب المرشحين). ويتضح من تزايد تجريم الحريات العامة، غياب الضمانات الأساسية للتعددية والتمثيل العادل اللازمة لإضفاء معنى حقيقي لهذه التغييرات. فبشكل خاص، تعاقب المادة 294 من القانون بالسجن من 3أشهر إلى 3 سنوات من يحاول «إقناع شخص بالامتناع عن التصويت». بالإضافة إلى أن عدم وجود ترتيب للمرشحين في القوائم المفتوحة لا يضمن احترام نتائج الانتخابات للمساواة بين الجنسين. كما حافظ الدستور المُنقّح في ديسمبر 2020 على منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة للترشيح في السلطة القضائية؛ وهو ما يثير مخاوفًا بشأن احتمالية تقديم الطعون الانتخابية.
في هذا السياق القمعي، قررت السلطات الجزائرية انطلاق الحملات الانتخابية. فأعلنت الأحزاب التسعة عشر المشاركة في الانتخابات عن رغبتها في بناء «الجزائر الجديدة»، ووصفت الانتخابات بأنها «نقطة تحول حاسمة لإعادة بناء مصداقية مؤسسات الدولة». أما الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي يعين رئيس الجمهورية رئيسها، فسلطت الضوء على اتجاه ملحوظ، مفاده أنه من بين 1483 قائمة للمرشحين في الانتخابات، يوجد 837 قائمة «للمستقلين»؛ مما يعني أن أكبر حزبين في البرلمان السابق –جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي– قد فقدا مصداقيتهما بسبب تورطهما في نظام بوتفليقة، وما تبع ذلك من محاكمة قادتهما بتهمة الفساد. والحقيقة، أن إفادات تتواصل عن استمرار شراء القوائم والفساد السياسي كظاهرة مستمرة، وفي الواقع تتكون قوائم «المستقلين» من أحزاب النظام السابق التي فقدت مصداقيتها. ومن الجدير بالذكر، أن 65٪ و 56٪ على التوالي من المرشحين في قائمتي حركة البناء الإسلامية وحركة مجتمع السلم ترشحوا كـ «مستقلين». وقد تم الترويج لهذا التطور باعتباره استجابة إيجابية لنداء الرئيس لمزيد من مشاركة الشباب والمجتمع المدني، وكنتيجة لأحكام قانون الانتخابات التي جعلت الترشح كمستقل أكثر سهولة من الترشح على حزب سياسي.
أعلنت الهيئة العليا أيضًا عن رفض 1200 قائمة، مبررةً ذلك بشكل أساسي بوجود «روابط مع دوائر تجارية وأموال مشبوهة». وعلى أكثر من مستوى، كانت مكافحة «الأموال القذرة» والحاجة لإظهار صورة من الشفافية والأخلاق في قلب هذه الانتخابات، بعد فضيحة سياسية مدوية حول الكشف عن عمليات شراء قوائم على نطاق واسع في سبتمبر 2020.
لقد وظَف النظام الجزائري هذه الانتخابات المبكرة في تعزيز صورة الإصلاح الديمقراطي، بينما واصل تشويه المعارضة باعتبارها عازفة عن المشاركة في «بناء المؤسسات الجديدة». وفي أعقاب غياب طويل للرئيس، تمثل الانتخابات المبكرة إعادة ترسيخ لسلطته، وتجديد قاعدة دعمه جزئيًا، خاصة مع دعم الأحزاب الإسلامية الموالية، وإعادة تدوير أحزاب النظام السابقة بتقديم مرشحيها باعتبارهم مستقلين. وسيغدو الامتناع عن التصويت أكثر العوامل المُحدّدة لمدى نجاح نهج النظام. كما يعد اختيار رئيس الوزراء من الأحزاب الإسلامية المشاركة في الانتخابات أمرًا محتملًا، الأمر الذي قد يؤدي لمزيد من تطبيع النظام مع الأحزاب الإسلامية، دون تغيير موازين القوى؛ طالما تهيمن الرئاسة على المؤسسات السياسية، ومن بينها البرلمان والحكومة.
أما المعارضة السياسية الرافضة لإجراء الانتخابات، فقد وجدت نفسها مستهدفةً بالقمع، إلى جانب المجتمع المدني والمعارضين السلميين. وواجهت الحركة الديمقراطية والاجتماعية والاتحاد من أجل التغيير والتقدم وحزب العمال الاشتراكي اعتقالات تعسفية، فضلًا عن الشروع في إجراءات تسعى لتجميد أنشطتهم، بعدما أعلنت هذه الأحزاب –المنضوية مع جماعات المجتمع المدني تحت ميثاق البديل الديمقراطي المؤيد للحراك– عن مقاطعتها للانتخابات، واصفةً إياها بـ «المسرحية الزائفة» التي تحافظ على «نظام سلطوي». وللسبب نفسه، رفضت غالبية هذه الأحزاب، باستثناء جبهة القوى الاشتراكية، دعوة الرئيس لحضور المشاورات التي تم تنظيمها في فبراير الماضي بشأن الوضع السياسي. وبالتوازي، في 6 مايو حُكم على طاهر ميسوم، النائب البرلماني السابق بالسجن عامين، لتهم تتعلق بمنشورات ناقدة. وفي 28 أبريل قُبض على المعارض السياسي كريم طابو، ووضع تحت الإشراف القضائي.
- تصاعد القمع للاحتجاج الشعبي يضع البلاد في مأزق سياسي
تعكس الحركات الاحتجاجية المتعاقبة مؤخرًا تزايد الاضطرابات الاجتماعية؛ بسبب نسبة البطالة المرتفعة، ونقص السلع الأساسية، وارتفاع التضخم، وانخفاض القوة الشرائية، وتراجع عائدات النفط. وقد ساهم إسكات السلطات لهذه الحركات في خلق ظروف مثالية لتعميق الاضطرابات وربما زيادة التطرف، خاصةً في المناطق الغنية بالموارد. ورغم أن الآمال التي خلفها الحراك في 2019 ساهمت في انخفاض واضح وكبير في الهجرة غير النظامية لأوروبا، إلا أن هذا الاتجاه انعكس في 2020، في استجابة للمأزق السياسي الذي خلقه القمع ضد الحراك؛ وليس واضحًا ما إذا كان هذا الرابط بين الهجرة والقمع قد تم أخذه في الحسبان في سياسات الهجرة الجزائرية والأوروبية.
إذا لم تقم الجزائر بإصلاحات طويلة الأمد في مجال الحوكمة، بما يعالج الافتقار للثقة والمحاسبة؛ فربما تواجه خطر عدم الاستقرار بشكل كبير، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية عميقة؛ من شأنها مواصلة الدفع باتجاه اللا مساواة والغضب الشعبي. وتظهر أهمية ذلك بشكل خاص، في ظل تأثير جائحة كوفيد- 19 على مفاقمة أزمة السيولة، والتي لا تسمح للحكومة بمواصلة دفع كلفة السلام المجتمعي، وتجعل من الصعب تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط. وبسبب النظام العسكري والدولة الريعية، يصعب الفصل بين الحريات السياسية والاقتصادية في الجزائر؛ ومن ثم، فإن معالجة قضايا مثل الفقر واللا مساواة و العدالة الاقتصادية تتطلب أيضًا معالجة الإقصاء السياسي والافتقار للحكم التشاركي. ويُعد فتح المجال لحرية التعبير مؤشرًا رئيسيًا على مدى قدرة الجزائر على التكيف مع هذا الوضع.
ولكن على عكس المطلوب، وبدلًا من فتح المجال العام، استغلت السلطات الجزائرية الخلافات السياسية داخل الحراك في خلق انقسامات، والاستفادة بشكل مضاعف من الاستراتيجية التي بدأها قائد الجيش السابق اللواء أحمد قايد صالح، والذي حذر في أبريل 2019 من «جهات أجنبية» تسعى إلى «التسلل إلى المظاهرات» و«زعزعة استقرار الجزائر». ففي خطاب ألقاه قائد الجيش في 19 يونيو 2019، قال محذرًا: «أود لفت الانتباه إلى قضية حساسة: بشكل أساسي، إلى محاولات أقلية صغيرة أن ترفع شعارات غير شعارنا الوطني في المجال العام». وجاء هذا الخطاب بعد يومين من الموجة الأولى للاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، التي شملت 41 شخصًا يحملون أعلام أمازيغية، تمت محاكمتهم بتهمة «تقويض الوحدة الوطنية» بموجب المادة 79 من قانون العقوبات. ومنذ يونيو 2019، باتت المادة 79 إحدى الوسائل القمعية الرئيسية المستخدمة كأساس لإدانة النشاط السلمي. فاستنادًا لهذه المادة، حُكم على الناشط السياسي كريم طابو في مارس 2020 بالسجن لمدة سنة (تتضمن 6 أشهر مع وقف التنفيذ)؛ لأنه انتقد القيادة العليا للجيش على الإنترنت. كما واجه الصحفي خالد دراريني في 15 سبتمبر 2020 حكمًا بالسجن لمدة عامين؛ لانتقاده شرعية الرئيس.
ومنذ عودة الاحتجاجات في فبراير 2021، لجأت السلطات إلى تكتيكات مماثلة، واتبعت استراتيجية البحث عن كباش فداء، مثل حركة رشاد التي تأسست في 2007، بشكل جزئي من أعضاء سابقين في جبهة الإنقاذ الإسلامية، وحركة تقرير مصير منطقة القبائل، وهي مجموعة سياسية أمازيغية تأسست في 2001 أعقاب أحداث ما يُعرف بـ «الربيع الأسود». وفي 22 مارس، أصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية بحق 4 نشطاء في الشتات، بينهم قائد حركة رشاد، العربي زيتوت، بزعم التورط في أنشطة إرهابية. وعلى مدار شهر أبريل، أعلنت وسائل إعلامية تابعة للدولة القبض على أفراد يخططون لهجمات إرهابية ضد مسيرات الحراك، بينما نفت حركة تقرير مصير منطقة القبائل اتهامات بالتورط في «خلية إجرامية خطيرة». وفي 19 مايو، حذر قائد الجيش الحالي، اللواء السعيد شنقريحة «المغامرين، بكل أطيافهم وخلفياتهم الأيديولوجية، من محاولة المساس بالوحدة الوطنية» في خطاب بعد يوم واحد من قرار المجلس الأعلى للأمن بتصنيف حركتي رشاد وتقرير مصير منطقة القبائل كـ «منظمات إرهابية». وفي الأسبوع نفسه، أذاع الجيش فيلمًا وثائقيًا يدين «المخططات التخريبية الإجرامية» للحركتين، وأدان وسائل إعلام فرنسية ومغربية وإسرائيلية.
جدير بالذكر أن النظام الجزائري لطالما لجأ لحيل “كبش الفداء” في مراحل سابقه متهربًا من المساءلة عن جرائمه، ففي أعقاب الحرب الأهلية، أغلقت قوانين العفو الباب أمام أي احتمالات للمحاسبة، فضلاً عن التوبيخ المستمر لأي منشور عن الحرب الأهلية ينحرف عن الرواية الرسمية، والملاحقات القضائية مثل معاقبة الصحفي إحسان القاضي. الأمر الذي لم يسفر سوى عن الإبقاء على التوترات الاجتماعية الحادة والإفلات من العقاب، رغم حقيقة أن المصالحة الحقيقية والمحاسبة أظهرتا فعالية كلبنة أساسية لمنع تجدد النزاع. مثل تلك الممارسات حظيت بدعم الشخصيات العامة والخبراء الموالين للنظام، والذين لديهم تحليل مفصل يعارض «الحراك الأصلي» ويعتبره حاليًا «الحراك المختطف»، الذي تلاعبت به قوى تخريبية. وتزعم تلك التحليلات دعمها لمطالب الحراك الأصلي، في مواجهة المطالب «المتطرفة» للحراك الحالي.
وبشكل عام، يمكن القول أن حراك مايو 2021، بعد عامين من القمع والجائحة، ليس بقوة حراك فبراير 2019. ورغم صعوبة الحصول على تقديرات دقيقة لأعداد المتظاهرين، يبدو أن المشاركة قد انخفضت نتيجة العراقيل المستمرة أمام التغطية الصحفية والوصول للمعلومات، كما تشير تحليلات أخرى لعدم انخراط الطبقة الوسطى في حراك 2021، إلا أن الجماهير المتبقية لا تزال متمسكة بالحريات التي استعادوها.
- تكلفة بلد متعطل في منطقة المتوسط والساحل
لا تزال الجزائر شريكًا أمنيًا واقتصاديًا ولاعبًا إقليميًا مهمًا في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل؛ ومع ذلك يبدو أن المجتمع الدولي قد تجاهل إلى حد كبير الحركة الاحتجاجية في الجزائر، مفضّلًا الوضع الراهن على تغييرات مؤسساتية غير مؤكدة. إلا أن العديد من التطورات تستحق انتباه الشركاء الدوليين للجزائر.
فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية، فقد ثبت أن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والتصنيفات الإرهابية التعسفية لمقاضاة المعارضين غير فعالة وتأتي بنتائج عكسية، إذ تساهم في مزيد من المظالم. كما أن الشروع في الملاحقات القضائية بحق 3 صحفيين وحقوقيين و15 متظاهرًا، بدعوى مزاعم ملفقة تتعلق بالإرهاب؛ يشير إلى تصعيد خطير أشبه بالممارسات السائدة في مصر والسعودية. ويشار في هذا السياق، لمحاكمة المحامي عبد الرؤوف أرسلان، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، بتهمة «اشتراكه في منظمة إرهابية» بناءً على دفاعه عن عضو في حركة رشاد، باعتبارها رسالة سياسية موجهة للمحامين.
وبينما تسيء السلطات الجزائرية استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، تواصل المحاكمات التعسفية لممارسي حرية التعبير والضمير، وتمنع فتح حوار جاد حول بعض القضايا الدينية. فعلى سبيل المثال، تم مقاضاة الناشطة أميرة بوراري والكاتب الساخر وليد كشيدة بتهمة «الاستهزاء بالمعلوم من الدين» (المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات). وفي أبريل 2021، حُكم على الباحث سعيد جاب الخير بالسجن 3 سنوات، استنادًا لمنشورات على الإنترنت تتعلق ببعض الطقوس الإسلامية، بعدما قدم مدرس جامعي بلاغًا بحقه في يناير 2020. وتفاقم هذا الوضع بحذف الإشارة إلى حصانة حرية الضمير في دستور 2020.
وفيما يتعلق بالقضاء على الفساد، فقدت حملة «مكافحة الفساد» التي انطلقت في 2019 مصداقيتها؛ بسبب الملاحقة القضائية التعسفية للمبلغين عن الوقائع والمخالفات، مثل نور الدين تونسي، الذي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سنة، بسبب تحقيقاته في وقائع فساد شركة مملوكة للدولة. كما يواجه أعضاء السلطة القضائية العديد من العقوبات التعسفية؛ إذ تعرض القاضي سعد الدين مرزوق، رئيس نادي القضاة الأحرار –اتحاد غير مسجل تشكل في 2016– ونائب النائب العام محمد بلهادي، إلى إجراءات تأديبية بسبب دعمها للحراك، ودفاعهما عن استقلال القضاء. كما أسفرت المحاكمات التي لا تتمتع بالشفافية والمسيسة لشخصيات من النظام السابق عن تسليط الضوء على الشبكة الواسعة للفساد، والمستفيدة من التواطؤ المزمن بين القطاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية، والتي يستحيل معالجتها دون حماية الحريات العامة واستقلال المؤسسات القضائية والرقابية.
وبصرف النظر عن عرقلة ترسيخ سيادة القانون، فإن النظام الجزائري يستهدف المجموعات التي قد تساهم في إصلاح البلاد، بما في ذلك الشباب والنخب الاجتماعية والسياسية، الأمر الذي قد يُفقِد السلطات شركاءها الموثوقين لإجراء الحوار. إذ أدى القمع إلى منع الحراك من التفكير في احتمالية التعاون مع النظام.
وإلى جانب تأثير الجائحة وإضعاف المجتمع المدني والمعارضة السياسية كإرث متبع للنظام السياسي وبسبب غلق المجال العام؛ ساهم القمع في منع الحراك من التنسيق داخليًا وبناء حركة منظمة، ومن ثم الحفاظ على البلاد في مأزق لا يمكن تحمله. وفيما يتعلق بشركاء الجزائر الدوليين، الذين تشمل أهدافهم دعم مجموعات المجتمع المدني –سواء المجموعات الحقوقية أو المنظمات الشبابية أو التنموية– فإن هذا التعاون يواجه أيضًا تعثر بسبب إغلاق المجال العام، وفرض القيود الشديدة على حرية تكوين الجمعيات. ورغم تأكيد الدستور على حرية تكوين الجمعيات؛ إلا أن الإطار القانوني شديد التقييد للقانون 12-06 بشأن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعديلات أبريل 2020 على قانون العقوبات، يجعل من المستحيل تقريبًا تأسيس واستمرار أي منظمة مجتمع مدني مستقلة في الجزائر اليوم. فالدول الراغبة في دعم المجتمع المدني الجزائري، دون ممارسة الضغوط على السلطات لإجبارها على احترام الحريات العامة؛ تخاطر بالسماح بتنامي المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومة، ومن ثم استبعاد الأصوات الشرعية.
وبغض النظر عن نجاح الحراك في تجاوز المأزق الحالي، فإنه مثّل نقطة تحول تاريخية لاستعادة المجال العام المغلق، وتبني التعددية ونشر ثقافة التمكين السياسي، في بلد كان يُنظر إليه حتى وقت قريب كاستثناء في منطقة تعج بالانتفاضات. لقد عاد الحراك مجددًا بعد الجائحة، وحافظ على التعبئة غير العنيفة لنحو 117 أسبوعًا على الأقل. ومن ثم، تم تشبيه الحراك بأنه «استقلال جديد»، الأمر الذي ينعكس بجلاء في تغير شعارات الاحتجاجات.
وبعد مرور عامين، وفي الوقت الذي يُظهر فيه النظام نفسه كنظام يحاول الإصلاح؛ فإنه لا يزال حبيسًا لأنماط حكم لا تتمتع بالشفافية أو المحاسبة، عاجزًا عن العودة بشكل كامل لما قبل الحراك، أو تقديم طريقة تتسم بالمصداقية للخروج من الأزمة. وربما تكون عدم قدرته على الاستجابة لواقع المجتمع الجزائري أحد المؤشرات الأولى على مدى هشاشته وعدم استمراره.
الصورة: آمي لويزا – ABACA / رويترز
Share this Post