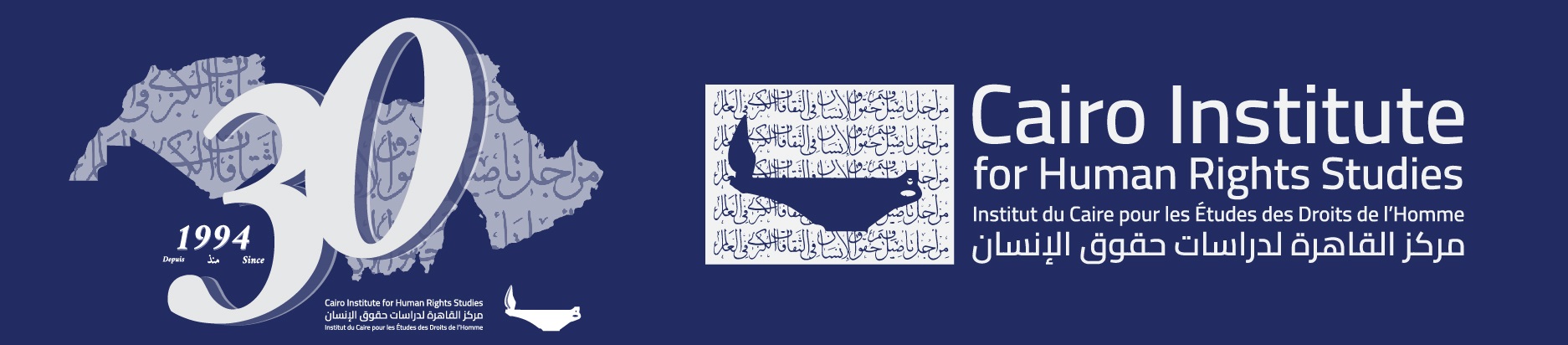بهي الدين حسن
النكتة الشائعة الآن في مصر ليست جديدة! وهى عن الأطباء الذين يهنئون أنفسهم بنجاح «العملية»، رغم أن المريض مات!
الجديد الوحيد في النكتة، هو توقيتها، أي الانتخابات البرلمانية في مصر، التي أفضت نتائج جولتها الأولى إلى إعادة إنتاج البرلمان الناصري الأحادي الصوت. فاز الحزب الوطني بنسبة 96.5 % من مقاعد الجولة الأولى، وخرجت أحزاب المعارضة بعدد من المقاعد يتراوح بين صفر ومقعدين، الأمر الذي أدى لانسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من الجولة الثانية.
إن ذبح المعارضة في الانتخابات بهذه الطريقة المشينة سيؤدى حتما إلى انتعاش الاتجاهات السياسية الراديكالية والنزوع للعنف، داخل وخارج الأحزاب والجماعات السياسية.
نجحت العملية الانتخابية.. وماتت العملية السياسية!
لقد حذرت مبكرًا عدة منظمات حقوقية، من أنه لا توجد أي مؤشرات على إرادة سياسية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفى مؤتمر صحفي لملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة في 9 نوفمبر، حذر البيان الصحفي الصادر عن المؤتمر من أن المؤشرات تدل على أن الانتخابات ستكون عملية فاسدة تماما. وبعدها بأيام، قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، إن أعمال تزوير إرادة الناخبين بدأت مبكرا، ولم تنتظر حتى يوم الانتخابات في 28 نوفمبر.
ولكن إعادة قراءة ساحة الحدث بعد يوم «الاقتراع»، تدل على أن ما حدث لم يكن مجرد تزوير واسع النطاق، بل هو أكبر عملية فساد سياسي منظم جرت في مصر في تاريخها الحديث. فاكتساح الحزب الوطني للانتخابات كان نتيجة جهد منظم ومنسق على أعلى مستوى، يصعب أن تجد له مثيلا في أي مشروع تنموي تبناه الحزب على مدار ثلاثة عقود.
أسهم في تنفيذ هذه «العملية»، اللجنة العليا للانتخابات، ووزارات الداخلية والعدل والإعلام والخارجية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. إلى جانب كتيبة من الكتاب والإعلاميين، الجاهزين للهجوم على الخصوم، ولإنكار كل اعتداء على حقوق الناخبين، والاستعداد –تمامًا مثل المستعمر الأجنبي–ـ لتبرير كل ما هو سلبي باعتباره ينبع من ثقافة المصريين، بدءً من رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، وانتهاءً بأعمال التزوير والعنف خلال يوم الانتخاب.
قبل بدء الانتخابات بنحو شهرين، كانت قد بدأت واحدة من أكبر الحملات المنظمة لتقييد حريات وسائل الإعلام، بمشاركة عدة أطراف.
استهدفت هذه الحملة إبعاد الإعلام عن العملية الانتخابية، وذلك من خلال التحكم في البث التليفزيوني المباشر من مواقع الأحداث، وحصره في قبضة وزارة الإعلام، وتوجيه عدد من الضربات المنتقاة ضد رموز إعلامية وصحفية وبرامج حوارية وقنوات فضائية، بما يؤدى لخلق مناخ من الخوف، يساعد على الهبوط بمساحة التغطية الإعلامية للانتخابات، ومضامينها، وتجنب تناول القضايا ذات الحساسية السياسية المرتفعة.
قبل يوم واحد من الانتخابات، صرح «بفخر» رئيس اللجنة التي شكلتها وزارة الإعلام لمراقبة الإعلام وإرهاب الإعلاميين، بأن التغطية الإعلامية خلال انتخابات 2010 أهدأ كثيرًا بالمقارنة مع انتخابات 2005. وفى يوم الانتخابات عجزت القنوات الفضائية عن القيام ببث مباشر بعيدًا عن رقابة الحكومة، وتعرض لمن قام بذلك من الاستوديو لقطع البث عدة مرات!
العملية «نجحت».. ولكن الإعلام «مات».
بالتوازي قامت إدارة المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية، بإبلاغ ممثلي المنظمات الدولية الحقوقية المقيمين في مصر، بعدم اتخاذ أي مواقف نقدية معلنة بخصوص الانتخابات، وإلا فإن طلبات هذه المنظمات لتسجيلها رسميًا سيتم رفضها وترحيل ممثليها.
في مرحلة فتح باب الترشيح تكفلت مديريات الأمن في المحافظات برفض قبول ملفات عشرات المرشحين، دون إبداء أسباب. وعندما لجأ هؤلاء للقضاء الإداري الذي حكم لصالحهم، كانت اللجنة العليا للانتخابات جاهزة لرفض تنفيذ الأحكام القضائية، بينما قامت وزارة الداخلية بالطعن ضد هذه الأحكام أمام محاكم غير مختصة قانونًا، لاستهلاك الوقت.
وعندما طعن المستبعدون أمام المحكمة الإدارية العليا ــ وهى واحدة من أعلى ثلاث محاكم في مصر ــ وحكمت لصالحهم، فإن اللجنة العليا للانتخابات رفضت مرة أخرى تنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية.
هكذا يولد البرلمان الجديد مطعونًا في مشروعيته القانونية، نتيجة وجود مئات الأحكام القضائية التي لم تحترمها هيئات وأجهزة الدولة، مهمتها الرئيسية هي إنفاذ القانون! وفقًا لبعض المراقبين فإن هذا هو أكبر عدد من الأحكام القضائية يحيط بميلاد برلمان في مصر.
العملية «نجحت».. ولكن مبدأ سيادة القانون «مات»
في مواجهة المطالبات العديدة بالسماح بالمراقبة الدولية للانتخابات، كان رد الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا حاجة لذلك في وجود رقابة منظمات المجتمع المدني المصرية. ولكن الأمر انتهى بأن حصل المجلس القومي لحقوق الإنسان على أغلبية التصاريح للمراقبين (6130 تصريحا)، وذلك لتوزيعها على عشرات الجمعيات التنموية والخيرية، التي ليس لدى أغلبها أي تجربة سابقة في مراقبة الانتخابات، فيما حصلت المنظمات الحقوقية على نحو 10% مما طلبته من تصاريح، ولم يحصل الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات على تصريح واحد!
هذا مثال نموذجي على تكامل الأدوار: وزارة الداخلية تبت في أي من المراقبين يستحق تصريحًا! وتعطى للجنة الضوء الأخضر لمنح آلاف التصاريح لمنظمات غير مؤهلة للمراقبة، وترفض الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي لتمويل الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، ووزارة التضامن الاجتماعي توقع خطاب الرفض وترسله، واللجنة العليا ترفض منح التصاريح للائتلاف، ثم يعلن رئيس اللجنة أن المنظمات التي تقول إنها لم تتسلم تصريحا بالمراقبة «تكذب». هل شاهدنا من قبل الحكومة المصرية تعزف بهذا التناغم الأوركسترالى؟!
المثير للسخرية أن التصريح لا يعنى السماح بالمراقبة، إنه وفقًا للجنة العليا تصريح للمراقب بمقابلة رؤساء اللجان!، الذين من حقهم أن يوافقوا أو يرفضوا ! وقد رفض أغلبهم.
نجحت «العملية».. ولكن الشفافية ماتت!
حتى يوم الانتخابات لم يكن وكلاء المرشحين من غير الحزب الوطني، قد حصلوا على تصاريح تسمح لهم بالوجود داخل مقار الاقتراع، بينما منحت أقسام الشرطة وكلاء مرشحي الحزب الوطني التصاريح قبل الانتخابات بيومين. كما اختارت وزارة العدل القضاة للجان العامة، دون استشارة الجمعيات العمومية للمحاكم. يوم الانتخابات جرت أكبر عملية لتسويد بطاقات الاقتراع في الانتخابات المصرية منذ 15 عامًا على الأقل.
نجحت «العملية».. ولكن النزاهة ماتت!
في اليوم الموعود، جرت الانتخابات بدون ناخبين تقريبا، فالناخب المصري يقاطعها يأسًا منذ أكثر من نصف قرن.
نجحت «العملية».. رغم أن المريض لم يكن موجودا فى «غرفة العمليات»!
للأمانة، لم يسود الحزب الحاكم بطاقات الاقتراع لحساب مرشحيه فقط، بل قام بذلك أيضا لصالح عدد منتقى من مرشحي المعارضة على حساب مرشحيه! كان التسويد كافيًا لفوز بعض المعارضين، أو دخولهم جولة الإعادة، بينما لم يكن كافيًا للبعض الآخر، فخرجوا. ليجد نظام الحكم نفسه أمام برلمان نظيف من معارضة ذات قيمة، خاصة بعد انسحاب الوفد والإخوان المسلمين.
أحد أهم أهداف هذه الانتخابات البرلمانية، هو تمثيل المعارضة بدرجة تسمح بمشاركة أكثر من «كومبارس» بارع، في الانتخابات الرئاسية العام القادم، بما يساعد على الإيحاء لجمهور المتفرجين من أغلبية المصريين والمجتمع الدولي، أنها انتخابات وليست استفتاء على شخص واحد. ولكن ذلك صار الآن حلمًا بعيد المنال.
نشر هذا المقال بجريدة الشروق
Share this Post