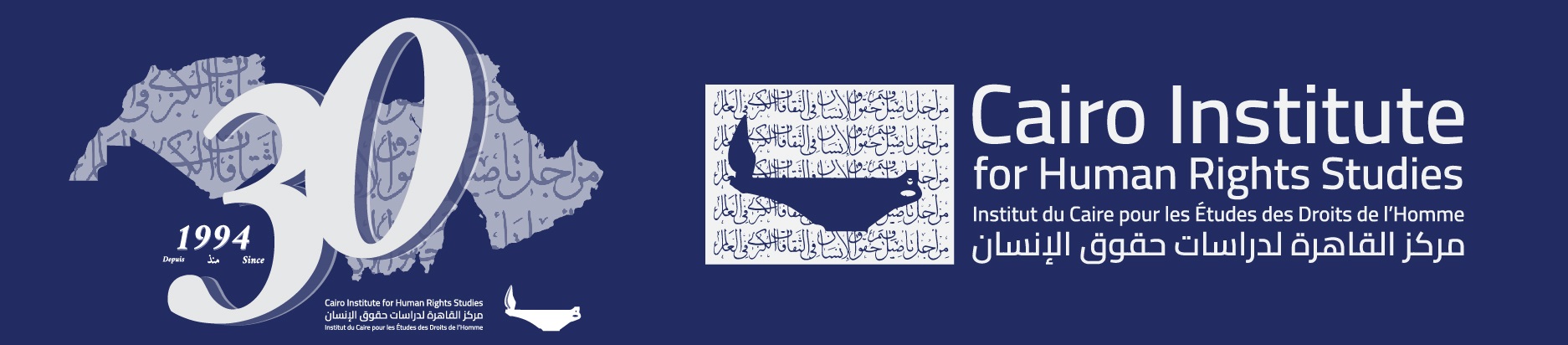بهي الدين حسن
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانأعتبر نفسي محظوظا.. هكذا خاطبت الاجتماع الثلث سنوي الثالث والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قبل أربع سنوات، على الرغم من أنني اضطررت إلى مغادرة مصر بعد تهديدي بالقتل، ولا أعرف متى سأتمكن من العودة إلى بلدي. أعتبر نفسي محظوظا، مقارنةً بعشرات ألوف المصريين الذين عبّروا عن آرائهم بطريقة سلمية منذ انتفاضة يناير 2011، فقتُلوا أو اختفوا أو ماتوا في السجون بسبب التعذيب، و/أو الإهمال الصحي المتعمّد مثل الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر منذ انقلاب يوليو 1952، بينما يمكث الباقون في طابور انتظارٍ بائس في السجون. عدد كبير من هؤلاء محكوم عليهم بالسجن بعد محاكماتٍ مسيّسةٍ وغير نزيهة، والباقي محتجز سنوات أو شهورا باتهامات ملفقة ومن دون محاكمة، بينما يعيش عشرات الملايين في جمهورية خوف.
عندما علمت بعد نحو ثلاثة أسابيع من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو/حزيران 2014، أنني مهدد بالقتل، تلقيت الخبر بهدوء، فقد عايشت الخطر متعدّد المصادر منذ ساهمت في تأسيس أول منظمة حقوقية في مصر منذ 35 عاما. بعد خمس سنوات، تلقّيت أول تهديد بالقتل من محامٍ مرتبط بإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة. بعد نحو عامين، اغتالت تلك الجماعة المفكر العلماني فرج فودة. قبل شهر من اغتياله، قدّم فودة ورقة تحليلية لوضع الأقليات الدينية في مصر، بدعوة مني في مؤتمرٍ كنت مشرفا على تنظيمه لتلك المنظمة الحقوقية، تعرّض خلاله فودة للتجريح من إسلاميين غير جهاديين، مثلما جرى معي قبله بعد إلقائي كلمة الافتتاح. خلال أكثر من ثلاثة عقود، كنت هدفا لحملات مزدوجة؛ حملات إسلاموية تتهمني بالكفر، وأخرى حكومية تتهمني بعدم الوطنية. لم يفزعني التهديد الأحدث بالقتل، بل صدمني التأكيد الصارم لمن استشرتهم أن التهديد، هذه المرة، جدّي بل وآنيّ. بعض من استشرتهم كانوا دبلوماسيين أجانب في مصر، ومسؤولين كبارا في الأمم المتحدة في مقرّها في نيويورك. في القاهرة، قالوا لي إن عليّ أن أغادر مصر فورا قبل منعي من السفر، بينما نصحني من قابلتهم في مهمة عملٍ لاحقةٍ في نيويورك، بإلحاح وتحذير من الندم بعد فوات الأوان، بألا أعود إلى القاهرة لتوديع الأسرة والأصدقاء.
بعد أن غادرت مصر، تعرّضت للتحريض على قتلي في برامج على الهواء من قنوات تليفزيونية مصرية. أحد المحرّضين عضو في البرلمان الحالي، ومعروف بصلته الوثيقة بالسيسي. أضاف، في اختتام تحريضه، أن الأجهزة الأمنية المصرية قتلت أمثالي من قبل، ثم أعادتهم في نعوشهم إلى مصر. ثاني المحرّضين اقترح أن يتم قتلي بالسم الذي استخدم حينذاك في محاولةٍ لاغتيال مواطن روسي في بريطانيا. ذلك باعتباري جاسوسا، لمجرّد تحدّثي بلسان الضحايا مع الأمناء العامين للأمم المتحدة وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء فيها، مثل الرئيس باراك أوباما ومستشارين للرئيس دونالد ترامب ولرؤساء ألمانيا وفرنسا والبرازيل ووزراء خارجية أميركا وغيرهم.
عندما قدّمت بلاغا للنائب العام ضد المحرض الأخير علي بالقتل، جرى حفظ البلاغ من دون تحقيق. ثم لاحقا، كافأ رئيس الجمهورية ذلك المحرّض على القتل بتعيينه في منصب إعلامي حكومي يراقب من خلاله مهنية تقارير الإعلام الأجنبي عن مصر! حينئذٍ، ثمّنت أكثر قيمة نصيحة الأصدقاء من الدبلوماسيين الأجانب.
خلال السنوات التالية لتهديدي بالقتل، صدر حكم قضائي بتجميد أموالي وأموال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى وحقوقيين آخرين ومنعهم من السفر. وبادر النائب العام (الذي سبق أن ألقى في سلة المهملات بلاغي ضد التحريض على قتلي) بإحالتي إلى المحاكمة في قضيتين متوازيتين، بسبب الاجتماعات الدولية التي أُدعى إليها، وآرائي المعلنة كحقوقي. خلال أحد عشر شهرا فقط، صدر ضدي حكمان قضائيان متواليان بسجني ما مجموعه 18 عاما، بتهمة إهانة القضاء ونشر معلومات “كاذبة”.
مع ذلك، ما زلت أعتبر نفسي محظوظا، ففي اللحظة التي تلقيت فيها خبر الحكم القضائي أخيرا بتوقيع عليّ أقصي عقوبة تلقاها حقوقي مصري، وذلك بسجني 15 عاما، تذكّرت، على الفور، الطبيب مصطفى النجار، أحد الشخصيات التي شاءت الظروف أن ألتقيها قبل أيام قلائل من مغادرتي الأخيرة مصر. كان أحد الرموز الشبابية الليبرالية لانتفاضة يناير 2011، ثم أسّس حزب العدل، وانتخب عضوا في البرلمان في العام التالي، بعد فوزه بأغلبية أصوات دائرته الانتخابية في مواجهة مرشح مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين. في إحدى مداخلات النجار البرلمانية، انتقد القضاء. وعلى الرغم من أن القانون يمنح حصانة لآراء البرلمانيين، إلا أن حكما قضائيا صدر ضده في عام 2017 بالسجن ثلاث سنوات بالتهمة ذاتها التي عوقبتُ عليها لاحقا. ولكن النجار، ذا الوجه البشوش دائما، أضيف اسمه إلى قائمة تضم آلاف المصريين مجهولي المصير، ممن اختفوا في سياقات أمنية في السنوات السبع الأخيرة. بعضهم يجري حفظهم في “حظائر بشرية” مفترضة، ثم يجري إخراجهم، والإعلان عن مقتلهم لاحقا في سياق ما تسمّى “مكافحة الإرهاب”، على الرغم من أن من الثابت أنهم كانوا في حوزة الأجهزة الأمنية، قبل الإعلان عن مقتلهم. كانت هذه الممارسة البشعة شائعة في بعض دول أميركا الجنوبية في القرن الماضي، وعرفت بـ”الإيجابيات المزيفة”.
أظن أن ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، يعتقد أن مهمته الصعبة في إقناع السيسي بالإفراج عن مواطنين أميركيين مصريين، وربما إنقاذ حياة مصطفى قاسم الذي توفي في يناير/كانون الثاني الماضي، كانت ستكون أيسر كثيرا لو كان قاسم ومواطناه مجرمين جنائيين. قبل أن يتولى شينكر منصبه، نشر قبل ثلاث سنوات مقالا عن مبادرات السيسي المتكرّرة بالعفو والإفراج عن قتلةٍ محكوم عليهم بأحكام نهائية، بينما يتعنّت في الإفراج عن أبرياء مسالمين. جرى تقنين هذه السياسة هذا العام، بتعديل قانوني جديد، يمنع العفو والإفراج المشروط عن المتهمين بالتجمهر والإضراب، بينما يبيح الإفراج عن مرتكبي جرائم القتل والعنف. وبمقتضى ذلك، عفا السيسي أخيرا عن آلاف المجرمين الجنائيين، بينهم أشهر قاتل مأجور في مصر. بينما تواصل النيابة كل يوم تلفيق اتهاماتٍ لنقّاده المسالمين، بدعم جماعة إرهابية لا يعرف المحققون اسما لها. بين هؤلاء الإرهابيين المزعومين نساء ورجال، أقباط وإسلاميون وعلمانيون معروفون وحقوقيون وصحفيون، ومحامون قُبض عليهم من غرف التحقيق مع موكليهم، وأطباء انتقدوا سياسات الحكومة في مكافحة كوفيد-19. .. ويعرف العالم أن برلمان مصر ليس أكثر من بصّامة. للأسف، المؤسسة القضائية على الطريق. لذلك ليس مدهشا أن تصف الأمم المتحدة بعض أحكامها بأنها “تسخر بالعدالة”!
عندما يعتقد الذين أملوا الحكم القضائي على حقوقي بأنه تمكّن منفردا من “الإضرار بالأمن القومي وبالنظام العام وبالمصالح الاقتصادية الوطنية وأعاق إنفاذ القوانين والدستور”، وأنه فعل ذلك كله، على الرغم من أنه لا يملك جيشا أو حزبا أو صحيفة، فإن على الرئيس الأميركي، ترامب، أن يراجع تقييمه ديكتاتوره المفضل، وقدراته على ضمان الاستقرار لدولةٍ بحجم مصر.
المصدر: العربي الجديد
الصورة: سمعان خوام
Share this Post