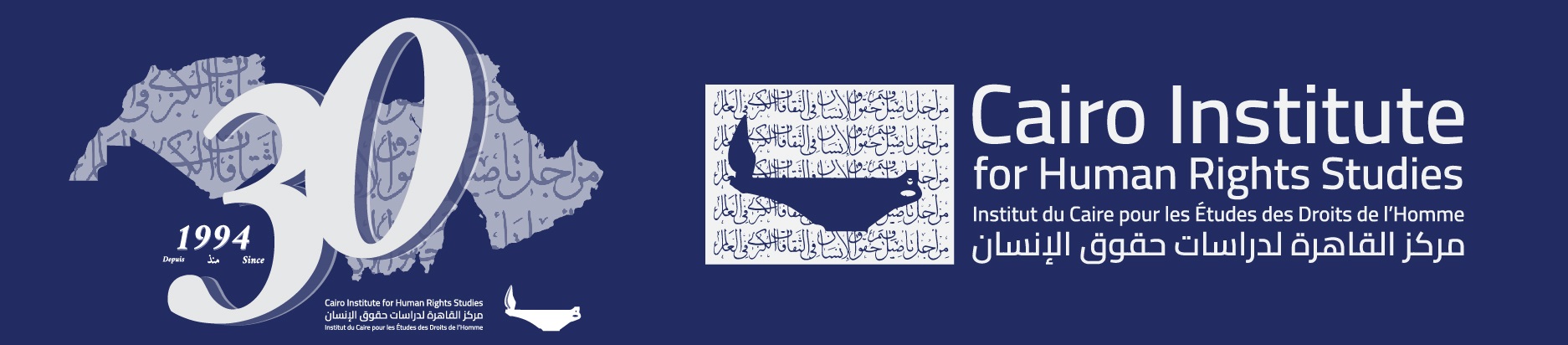كمال جندوبي
ناشط حقوقي في تونس ورئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. شغل منصب وزير مكلّف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية من فبراير 2015 إلى أغسطس 2016.
حينما أُعلنت الجمهورية في 25 يوليو 1957، وانتخب المجلس التأسيسي الأول الحبيب بورقيبة كأول رئيس، قبل وقت طويل من المصادقة على الدستور عام 1959، كانت نيّة وروح القادة تتمثّل في خلق نظام سياسي جمهوري يمنح زعامة الدولة إلى «المجاهد الأكبر» الذي يمتلك السلطة في البلاد بشكل حصري تقريبًا. انتفضت الجمهورية الأولى ضد النظام الملكي، معلنة نظام الدولة المستقلّة الجديدة. لكن الشّعب «الذي بلغ –بحسب بورقيبة– درجة كافية من النضـج لإدارة شئونه الخاصة»، كان عليه الاسترشاد في اختياراته بـ «الزعيم» الذي أصبح «الرئيس» محرّر البلاد، وأب الأمة. أما الديموقراطية فعليها الانتظار.
بعد أربعة وخمسين عامًا، دقّت ثورة 2011 أخر مسامير نعش الديكتاتورية، منهيةً بذلك الاستبداد «الجمهوري» لزين العابدين بن علي، ومفسحة الطريق أمام جمهورية ثانية؛ أولًا، من خلال معارضة محاولات إحياء الديكتاتورية، وتاليًا من خلال تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي لإعطاء الدولة أسسًا قانونية جديدة. فهل أصبحت هذه الجمهورية الثانية ديمقراطية من خلال إدماج المواطنين دون تمييز في مسار صنع القرار؟
على مدار العقد من 2010 إلى 2020، ارتفعت الأصوات بصفة دورية لتناشد الجمهورية تجديد الارتباط بشعارات الكرامة والعمل والحرية التي ولّدت الثورة. وتمثلت هذه الأصوات في الحركات الاجتماعية المتصاعدة، وصرخات المناطق المحرومة والأحياء الشعبية التي تتمظهر بشكل دوري، وصولًا لاحتجاج الشباب في يناير2021. كانت تلك الأصوات بمثابة دعوة للجمهورية، المتحفظة أو الغافلة حتى ذلك الوقت؛ لتجديد رسالتها وحشد قواها وإعادة التفكير في مشروعها.
ليست الجمهورية وصفة سحرية للخروج من الأزمة، وإنما هي مسألة معارك ونضال ضد القوى الراغبة في انتكاسها وضد أولئك الذين يسمون أنفسهم جمهوريين بينما هدفهم إعادة إحياء الرؤية الواحدة السائدة منذ الاستقلال. أولئك لا يملكون سوى عبارة «خلاص الوطن»، وبرغم ادعائهم الرغبة في إنقاذ الجمهورية لكنهم لا يقترحون أي إجراءات جمهورية لإعادة بناء المجتمع ودمج المنبوذين وحماية ضحايا التمييز. لقد ولدت الجمهورية اجتماعية، وستموت حينما تنكر ذاتها.
وفي سبيل أن تصبح جمهورية حقيقيّة، يتحتم عليها تحقيق الكرامة والحرية والعدالة والنظام، وأيضًا المساواة كي لا تستثني الشعب المحروم من حقوقه أو تضعه على الهامش. هذه هي روح المؤلّف الجماعي «عاشت الجمهورية!» تونس 1957-2017 الهادف «للحديث عنها وتوصيل صوتها».
الحديث عن الجمهورية … ونكساتها
الحديث عن الجمهورية يستلزم العودة لأهم الأحداث والوقائع الممهدة لظهورها، ووصف المسار الذي سلكته منذ إعلانها.
كان التدهور المخيف للمملكة تحت حكم البايات رغم إصلاحات زمن النهضة، ثم الصدمة الاستعمارية التي دفعت بمسار الحداثة قسرًا لصالح المحتل، السبب المباشر لتشكيل مقاومة ظهرت عبر حركة فكرية وأدبية للنخبة التونسية، ومن جهة أخرى عبر تعبئة حركة وطنية وحراك نقابي فاعل بالتنسيق مع البايات الوطنيين.
اقترنت ظروف إعلان الجمهورية عام 1957 في العديد من الكتابات، بالإطاحة «غير المتوقعة» للباي بموافقة غالبية التونسيين؛ الذين وجدوا في تخاذل الباي الأخير لمين باي أمام المستعمر أسبابًا للتخلي عنه، خاصّة أنه اعتلى العرش بعد إقالة السلطة الاستعمارية للمنصف باي.
وأرست الجمهورية الأولى –بقيادة الحبيب بورقيبة– أسس الدولة المستقلة الجديدة بتبنيها، مجموعة قوانين هادفة للتحديث مثل: إصلاح الإدارة الجهوية، وإلغاء نظام (القايد) وتشكيل الولايات والبلديات، وإلغاء الحبوس العامة، ونقلها إلى الملك العام، و«تونسة» الأجهزة الأمنية، والمصادقة على قانون الأحوال الشخصية، ومجانية التعليم للجميع، وتشكيل النواة الأولى للجيش الوطني. هذه القوانين التي صادق عليها الباي (مراسيم الباي) قبل الإطاحة به.
جمهورية الملك
«أعرف مقدار المودة (التي يكنّها الشعب التونسي) لي. اعتقد البعض أنني يمكن أن أتولى مسئولية مصيره. لكنني أحترم الشعب لدرجة أنني لا أتمنى له سيدًا وأن الخيار الوحيد الذي يمكنني إرشاده إليه هو خيار الجمهورية». مقتطف من خطاب الحبيب بورقيبة أمام المجلس التأسيسي في 25 يوليو 1957.
وهكذا تأسست الجمهورية بشعار: «الحرية والنظام والعدالة» والنشيد الوطني كأغنية ترددها أجيال التونسيين بمعنويات مرتفعة. وتعزّزت الجمهورية بإقرار دستور 1959 الذي نصّ الفصل الأول منه على أن «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، العربية لغتها والجمهورية نظامها». وأنشأت الجمهورية مشاريع ضخمة، لا تزال آثارها جلية، من بينها علمنة مؤسسات الدولة والمجتمع، وتطوير المرافق العامة، تعميم التعليم ومجانيته، والصحة للجميع، والتنظيم العائلي. وبمجرّد استعادة السيادة الوطنية إثر معركة بنزرت وجلاء القوات الفرنسية، اتبّعت تونس ديبلوماسية منحتها ثقلًا يتجاوز وزنها الاقتصادي أو الديموغرافي.
ثلاثون عامًا غيّرت البلاد، لقد تغيّر المجتمع بشكل جذري. لكن لم يتم الإيفاء بالوعد الديمقراطي. فمنذ البداية، انحرفت الجمهورية عن مبادئها، ونصّبت عليها ملكًا (بورقيبة رئيسًا مدى الحياة)، ووضعت «النظام قبل الحرية والعدالة»، لتصبح بذلك جمهورية الحزب الواحد (الحزب الاشتراكي الدستوري) وذلك من خلال التضييق على المعارضة بالحظر والقمع، والاعتقالات، والمحاكمات، والتعذيب.
نهايات حكم «الملك الجمهوري» المليء بالدسائس وحرب المجموعات داخل دوائر السلطة، فضلًا عن المواجهة مع الإسلاميين (حركة الاتجاه الإسلامي، سلف النهضة) في الخلفية، سمحت لجنرال الاستخبارات بن علي بتنظيم انقلاب طبي في 7 نوفمبر 1987. متعللًا بالشيخوخة وتدهور حالته الصحية ومتذرعًا بالواجب الوطني ليعلن عجزه عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية التي تعود إليه بموجب المادة 57 من دستور 1959، وكذلك القيادة العليا للقوات المسلّحة.
الجمهورية المشوّهة
بإعادته للجملة التي ألقاها بورقيبة أمام المجلس التأسيسي كلمة بكلمة «لقد بلغ شعبنا درجة من الوعي والنضج»، أكدّ إعلان 7 نوفمبر 1987 على أنّ «كل أبناء وفئات الشعب يمكنهم المشاركة البناءة في تصريف شئونه في ظل نظام جمهوري يمنح المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسئولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نص الدستور».
آمن غالبية المواطنين حينها بتغيير حقيقي ودمقرطة البلاد، ما جعل إعلان 7 نوفمبر1987 شبه ديباجة للدستور؛ «فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية». لقد كان الأمل يولد من جديد، ولكن بمجرد توليه زمام السلطة، عمل بن علي على إخضاع القانون لتعسّفه من خلال تعديلات دستورية؛ إذ ألغى التولّي التلقائي للوزير الأول (الثغرة التي انزلق من خلالها)، وألغى اختصاص الوزير الأول في «التصرف في الإدارة والنظام العام»، وعدّل الفصل 63 بحيث لا يمكن إجبار الرئيس على الاستقالة، حتّى في حالة تبني مجلس النواب للائحة لوم مفترضة وغير محتملة (القانون الدستوري رقم 88-88 المؤرخ في 25 يوليو 1988).
التعديل الأخير في 1997 (القانون الدستوري رقم 97-65) أسس نظام «الرجل القوي»، موسعًا مجال الاستفتاء بشكل غامض ومشبوه، يسمح له بتولي زمام المبادرة منفردًا. وهو ما فعله بعد أربع سنوات. وفي 26 مايو 2002 أجري استفتاء شعبيًا، كان بمثابة إعلان وفاة الجمهورية، واعتداء على العدالة حيث حصّن المواطن التونسي من الدرجة الأولى –الرئيس– نفسه من أي رقابة أو عقوبة شعبية أو قضائية للأبد!
خلال الفترة من نوفمبر 1987 إلى يناير 2011، تولّى بن علي الحكم منفردًا دون منازع، معتمدًا على جهاز شرطة أخطبوطي للقضاء على خصومه السياسيين. وفي أعقاب قمع الحركة الإسلامية أوائل التسعينيات، تعرّض المجتمع بأسره إلى حصار بوليسي بهدف القضاء على أي محاولة للاحتجاج، مستخدمًا التعذيب بشكل منهجي لانتزاع الاعترافات وإدانة المتهمين من خلال قضاء مسيس وخاضع للأوامر، غير مبالِ بمعاناة الضحايا وعائلاتهم. وبالإضافة لأساليب القمع الكلاسيكية التي تمارس في وضح النهار، تم استعمال أساليب الظل، التي امتدت إلى المجال الاقتصادي؛ فتحوّلت الجمهورية إلى نظام هرمي يحكمه رئيس يعتمد على الأقارب الذين يمارسون قانون الصمت، وغالبًا ما تجمعهم روابط القرابة و/أو الولاء، بجانب التكنوقراط الوصوليين.
كان المناخ المرافق للانحراف الاستبدادي يزيح السياسة من الحياة اليومية والحياة العامة والإعلام، كان كل شيء يسير لتصبح السياسة مسئولية الرئيس وحده.
شوّه النظام الاستبدادي والبوليسي –المعتمد على ركيزتيه: الاستبداد والمحسوبية– الجمهورية لمدة 22 عامًا. في السابق، تمت الإساءة للجمهورية عدّة مرات وعرفت بعض النكسات خلال فترة بورقيبة. كان من الممكن أن تستند هذه الجمهورية إلى دستور يحافظ على روح المؤسسين، ويسمح لتونس بالوصول للحداثة السياسية. ولكن في الواقع، لم يحدث شيء، وكانت حقبة «بن علي» بمثابة عقاب على الخيارات المأساوية للجمهورية الأولى. في المقابل، لم يكن واردًا لـ «بن علي» وعائلته وأقاربه، الذين انخرطوا بصفة كليّة في الفساد المتفشي، أن يتصوّروا ولو للحظة واحدة إمكانية تناوب لطيف ومتفاوض عليه.
الثورة أو أمل جمهورية جديدة
لقد دقّت الحركة الرمزية للغاية للبائع المتجول محمد البوعزيزي أخر مسامير نعش جمهورية الخوف. فبإضرامه النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010، عقب مشاجرة مع أحد أفراد الشرطة، أشعل حلقة من الانتفاضات انطلقت من مدينة سيدي بوزيد إلى جميع أنحاء البلاد. واحتشدت القوى المختلفة في البلاد من (شباب، نساء، محامين، نقابيين، طلاب …) للمطالبة برحيل الديكتاتور. وسقط 319 شهيدًا برصاص قوات الأمن، وحمل 3.729 مصابًا علامات عار الديكتاتورية على أجسادهم إلى الأبد. هم شهداء وجرحى الثورة الذين تناستهم الجمهورية.
منذ ذلك الحين، انطلقت البلاد في طريق إعادة إحياء الجمهورية، وهو طريق مليء بالنضالات والتضحيات. وفي 14 يناير 2011، وخوفًا من مصادرة الثورة بالإعلان عن حكومة مكونة أساسًا من قادة سابقين للحزب الحاكم منذ عام 1956(التجمع الدستوري الديمقراطي)، انطلق الشباب من جميع أنحاء البلاد لتونس العاصمة لتحقيق أكبر احتلال للفضاء العام في تاريخ تونس (القصبة 1 و2)، ما أجبر محمد الغنوشي، الوزير الأول آنذاك، على تعديل الحكومة، ثم في 27 فبراير 2011، على الاستقالة. فبدلًا من التغيير انطلاقًا من الأعلى، بناءً على مراجعة أحكام دستور 1959 أو على إصلاحه في شبه عزلة، فرض الشارع مسارًا آخر «من الأسفل»، عن طريق انتخاب المجلس التأسيسي، أي إعادة تعريف أسس الجمهورية.
انطلقت بذلك فترة مؤقتة إثر تعليق العمل بدستور 1959 وجميع المؤسسات ذات الصلة، باستثناء القضاء. وعين فؤاد المبزّع، الرئيس المؤقت، الباجي قائد السبسي رئيساً للحكومة المؤقتة لإدارة الشئون اليومية، بموجب مراسيم، حتى الانتخابات. كما تفاوض مع الفاعلين في المجتمع المدني وأحزاب المعارضة على إنشاء هيئة لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي (المعروفة باسم الهيئة العليا)، وهو نوع من البرلمان المرتجل. وتجمع الهيئة ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات المهنية والأحزاب السياسية المعارضة وكذلك المناطق الداخلية. كانت هذه الهيئة مسئولة عن تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات. كما صاغت العديد من المراسيم، التي اعتمدتها الحكومة وصادق عليها رئيس الجمهورية، ومن بينها قانون الانتخابات، والقانون المتعلّق بهيئة الانتخابات، والقوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب. من جهتها، تبنت الحكومة المؤقتة سلسلة من الإجراءات لتحرير الحياة العامة، مثل التراخيص الممنوحة لمئات الجمعيات والأحزاب الجديدة ووسائل الإعلام وغيرها، ورفع التحفظات التي أبدتها الديكتاتورية على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، كما أصدرت عفوًا تشريعيًا عامًا.
بثّ الحياة في الجمهورية
في 2011، جرت أول انتخابات ديمقراطية ونزيهة في تاريخ البلاد، وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي استمر حتى يناير 2014، ومنح ثقته لثلاث حكومات، وفي نهاية المطاف، قدم في 26 يناير 2014، نسخته من الدستور. في تلك الأثناء، ساد مناخ من الخوف والعنف النفسي والجسدي، وأدى تساهل الأغلبية الحاكمة معه لتعزيز ظهور الإرهاب الإسلامي. في ذلك الوقت كانت الجمهورية في خطر؛ إذ أصبحت مؤسساتها وجيشها وقوى أمنها الداخلي أهدافًا للهجمات، وعاش الشعب في خوف، كما تعرض المسئولون النقابيون والشخصيات السياسية والمفكرون والصحفيون والنشطاء للتهديد بالموت، وصولًا لاغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
المقاومة المجتمعيّة انتظمت إلى حد كبير بفضل حشد النساء، لتبلغ ذروتها في اعتصام الرحيل أو باردو، الداعي لحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة. ثم بدأت المواجهة التي أنتجت حوارًا وطنيًا برعاية أربع منظمات حصلت على جائزة نوبل لاحقًا وهي: الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين. وتمّت المصادقة على الدستور وبدى أنّ الجمهورية في أمان. وفي أعقاب ذلك، بدأت دورة انتخابية جديدة للبلاد تهدف لإنشاء مؤسسات ذات مشروعية؛ الانتخابات التشريعية لمجلس نواب الشعب، والانتخابات الرئاسية في 2014 و2019، والانتخابات البلدية في 2018. ورغم تواصل المسار الانتخابي، إلّا أنه كان من الواضح عجز الفاعلين السياسيين، وعدم قدرة التشكيلات الحزبية على تكوين مؤسسات وضوابط وتوازنات قوية ومستدامة. تبدو جمهورية 2021 وكأنها قارب مخمور يبحر عبر الضباب.
بعد سبع سنوات من المصادقة على الدستور، يثير المنعطف الذي تأخذه الأحداث حاليًا القلق، بعدما تمّ تقويض الأمل السياسي والاجتماعي الذي حملته ثورة 2011 مع الخطر الكبير لدفن المشروع السياسي الثوري.
إن بثّ الحياة في الجمهورية هو تأكيد للمحتوى المدني لحب الوطن، المتمثل في الاتفاق على سردية جماعية دون الوقوع في فخ الحنين للآباء المؤسسين، وهو قبل كل شيء، الاهتمام بحياة الناس هنا والآن؛ الشباب والنساء والخريجين العاطلين والأقليات ومناطق بأكملها. هؤلاء الذين أشعلوا الشعلة وقدّموا الشهداء وينتفضون لشعورهم بالتهميش والإقصاء أكثر فأكثر من الجمهورية. يجب الذهاب لما هو أبعد من تعويذة الديمقراطية الإجرائية والمواعيد الانتخابية، يجب صنع خيال جمهوري مشترك يحمل الأمل السياسي والاجتماعي الكبير للثورة.
“الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة، القادرة على تبوء مكانتها في العالم، والانتقال بين فضاءات انتماءاتها المختلفة، في المغرب الكبير، في إفريقيا، في البحر الأبيض المتوسط، في العالم العربي الإسلامي، هذه الجمهورية ليست ضربًا من الخيال، بل في متناول أيدينا. علينا إدراك ذلك، والرغبة فيه، وعلى ضوء احترام الدولة للمواطنين، على كل فرد أن يفي بواجبه. وبهذه العبارات المفعمة بالأمل، ينتهي كتاب «عاشت الجمهورية!، تونس 1957 – 2017».
المصدر: نشرت باللغة الفرنسية على نواة
Share this Post